مقدمة
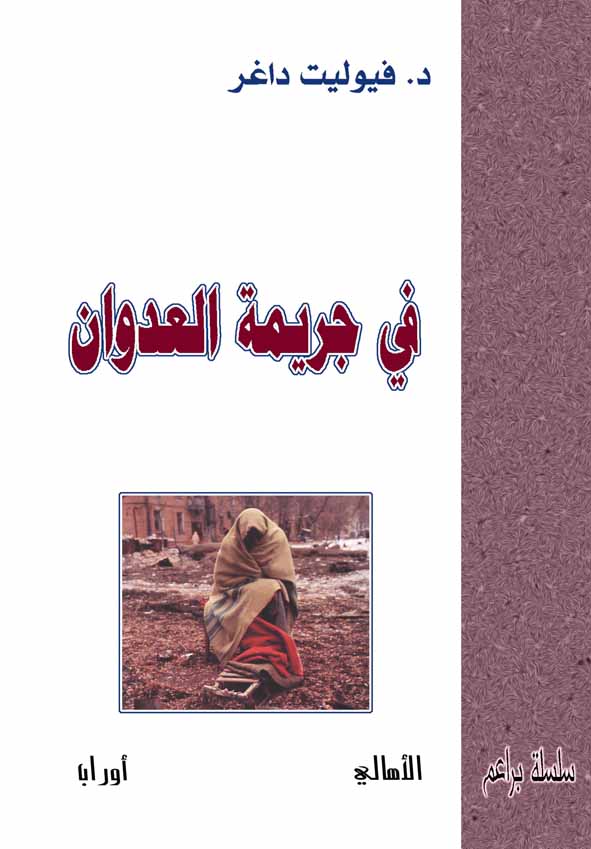 استعجل
القراء بالقول، إن كان همكم البحث عن الجانب القانوني في جريمة العدوان،
فلن يشبع هذا الكتاب عطشكم، فقانونيون مثل الأستاذ عبد العزيز شكري وغيره
من المختصين الكبار العرب والعجم، أكثر كفاءة مني في عرض الإشكاليات التي
يعانيها مفهوم جريمة العدوان في القانون الدولي منذ استعملت كلمة القانون
الدولي، بل ومنذ تشكلت أول لجنة لتعريف جريمة العدوان عام 1948 الأمر الذي
جعل هذه الجريمة، مضافة غير معرفة لا في أركانها المادية والمعنوية ولا في
قصدها الجنائي، وذلك في كل من العرف الدولي وفي ميثاق روما للمحكمة
الجنائية الدولية. ومازالت نقاشاتها تجري، ولكن هذه المرة، بغياب الطاقات
العربية، لأن الدول العربية باستثناء الأردن وجيبوتي لم تجد بعد من الضروري
أن تصدق على ولادة المحكمة الجنائية الدولية. استعجل
القراء بالقول، إن كان همكم البحث عن الجانب القانوني في جريمة العدوان،
فلن يشبع هذا الكتاب عطشكم، فقانونيون مثل الأستاذ عبد العزيز شكري وغيره
من المختصين الكبار العرب والعجم، أكثر كفاءة مني في عرض الإشكاليات التي
يعانيها مفهوم جريمة العدوان في القانون الدولي منذ استعملت كلمة القانون
الدولي، بل ومنذ تشكلت أول لجنة لتعريف جريمة العدوان عام 1948 الأمر الذي
جعل هذه الجريمة، مضافة غير معرفة لا في أركانها المادية والمعنوية ولا في
قصدها الجنائي، وذلك في كل من العرف الدولي وفي ميثاق روما للمحكمة
الجنائية الدولية. ومازالت نقاشاتها تجري، ولكن هذه المرة، بغياب الطاقات
العربية، لأن الدول العربية باستثناء الأردن وجيبوتي لم تجد بعد من الضروري
أن تصدق على ولادة المحكمة الجنائية الدولية.
كذلك أود القول لتقنيي المعرفة الحقوقية، لن تجدوا مرادكم،
لأن الكتاب ينطلق من ضرورة كسر المنطق الأحادي النظرة، والاختصاص من أجل
الاختصاص ويجنح لتحليل جدلي يبحث عن عناصره في النفس والمجتمع، الثقافة
والقانون، المقدس والمدنس وأخيرا القوة والعدل.
حاولت النظريات الكبرى فردانية كانت أو جماعية، مادية أو
مثالية، فلسفية أو دينية أن تقدم منطقها الخاص في فهم التاريخ والواقع
والمستقبل، وبهذا المعنى، كانت القوة الذهنية لأنصار هذه الاتجاهات تتركز
في البحث عن الخيوط المنطقية أو العقلانية لمسيرة الأشياء، سواء ارتبطت هذه
المسيرة بقوى الإنتاج أو تطور الدولة أو تنامي العقائد. ولكن يبدو لنا أكثر
فأكثر، أن الدول التي تعيش على هامش الاقتصاد والثقافة والتنمية، لا تخرج
وحسب من منطق التاريخ بتفسيراته المختلفة، وإنما أيضا من إمكانية الفهم
المنطقي، فهي لا عقلانية في قمعها، لا عقلانية في جشعها، لا عقلانية في
منظومة فسادها، لا عقلانية حتى في الدفاع عن مصالح من أوصلها إلى حالة
التدمير المنهجي للعقل هذه.
كتب صاحب موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان في 28/08/1990:"في
العالم الغربي، كانت الاشتراكية موضوع الشبيبة والشغيلة والمثقفين، في
العالم العربي النهضة كانت كلمة السر، القرن العشرين بدأ خصب الوعود خصب
الطموحات بحيث صار من أحلام الكثيرين مجرد البقاء على قيد الحياة حتى عام
2000، ليشهد نهاية الألفية الثانية بما تحمله هذه الكلمة من شحنات رمزية.
البعض ظّن ألفية الشيوعية قادمة، والبعض الآخر سجل نبوءة عودة الأديان..
قلة كتبت بأن العمال هم الذين سيزعزعون سلطة البيروقراطية التي تعتبر نفسها
الممثل الشرعي الوحيد لمن تشمله كلمة بروليتاريا.. وأقل منهم من توقع إباحة
الجنس خارج الزواج على لسان ملا وفتوى استدعاء قوات احتلال. إن نوازع البشر
المتفاوتة والمتضاربة تتجاوز كل أشكال التعليب الإيديولوجي، ورغم تقديم
الميدياقراطية لحلم قطاعات واسعة من البشر الإنكفاء على أنموذج الجشع
الغربي أو في إقامة الحدود، فما زال الإنسان يخبئ في أعماقه رفضه وانصياعه،
كبته وحريته، تحضره وبربريته ومجاهيل عالم قادم ثمة بعد من يحلم بإنزال
الجنة إلى الأرض فيه.
إن حرب الإنسان تبدأ مع جزء منه اسمه العدوانية أو
البربرية، لا يهم، وهذا الجزء هو الذي يطرح علينا باستمرار الأسئلة الأقدم
والأعمق حول تعريف تفاؤلي لإنسانية الإنسان في عالم الغاب القائم، وإن كان
من صرخة أعلنتها فورات المدن وأناشيد الانعتاق وإضرابات الطلبة فهي في
التذكير بأن العنف مازال يرسم معالم القادم وهدم القائم، المعلوم وإعلان
المجهول: زوابع الخليج أعطت المثل، وستطبع دون شك، زوابع الضياع العام في
نهاية الألف الثاني. آخر مسحات تفكير عن ألف عام جديد نستقبله بخطر طبول
الحرب". (تحديات التنوير، ص162). منوها في مقدمة الكتاب: "إن كانت فلسطين
قد طبعت ما مضى، فإن الخليج سيؤثر على كل قادم".
هذه العدوانية التي تبدأ بالأنا فالنحن فالآخر، هي وحدها
القادرة على تخطي المفهوم السطحي لجريمة العدوان، إلى قراءة أكثر تعمقا.
فالتناول السطحي من قبل ممثلي الحكومات لم يعط في هذا الملف، في أغلب
الحالات، أكثر من نصوص اغتيلت قبل ميلادها، وعندما تحاول بعض الومضات
الإنسانية عند مسؤول في الأمم المتحدة أنهكته ضغوط المعتدي، يصبح الخيار
بين مذكرات لا تجد ناشرا والبقاء في مهنة لا طعم لها ولا رائحة ولا لون
وأخيرا وليس آخرا مأساة كالتي ذهب ضحيتها سيرجيو دي ميلو.
لأن العدوان هو في القاعدة، عمل يقوم به القادر عليه، ولا
يعتدي الضعيف إلا في مستوى ما يسميه العامة "فشة الخلق"، وبشكل أهوج ولا
عقلاني، الأمر الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع، بل ويسمح للقوي باستعمال
تعبير الإرهابي بحق هذا الضعيف الذي يخسر الألوان الجميلة لقوس قزح عدالة
قضيته. وكما قال أحد الكتاب الفلسطينيين يوما عندما عرضت نيوزيلندا،
الضائعة في ذاكرة وجغرافيا شعوب الخليج، خدماتها على بيل كلنتون لتخوض معه
حربا على العراق: حتى أنتِ يا نيوزيلندا! يغري خطاب القوي كل المنافقين،
فالغالب، كما يقول ابن خلدون، مولع بتقليد الغالب، ولا يعدم من المثقفين من
يتحدث عن ضرورة اغتصاب الضحية لإخراجها من سباتها الطويل. فأحسن تفسير
للعزلة بين كاتب ومجتمعه أن يلقي بالمسؤولية على هذا المجتمع، بل ويطالب
بعملية تأديبية خارجية تبدأ بالقمة وتنتهي في القاعدة.
هذه المحاولة تطمح لتكسير بعض المسلمات التي دخلت عالم حقوق
الإنسان من منظمات شمالية وسميت بالعالمية، وبنفس الوقت تهدف لتكسير الهالة
المقدسة للمعتدي، وتنتصر للمظلوم دون أن تعطيه أية صفة عصمة أو تفوق رد
فعلي. بهذا المعنى، فهي لا تتعدى كونها مقدمة لموضوع هام وحساس، مقدمة
تتطلب جهدا جماعيا يذهب بها بعيدا بحيث تتحول جريمة العدوان بالفعل والقول،
إلى جريمة جسيمة ضد الإنسانية وضد الاحترام الضروري المتبادل بين الشعوب
وبين الأفراد.
الإرهاب والمجتمع المشهدي
دخلت الولايات
المتحدة منذ فترة مرحلة تراجع ما كان من أحداث 11 أيلول سوى التعجيل بها
وتعريض العالم لمخاطر جمة إن استمرت البلد الوحيد المتحكم بخيوط اللعبة
الدولية. خلال هذه الأثناء، لم تسارع أوروبا كما كان يفترض لشغل هذا الفراغ
بفرض مواقف تعيد من خلالها بعض توازن للعلاقات الدولية. فالعولمة بشكلها
الحالي يجب أن تخضع لرقابة أكبر في وقت تعاني فيه القوة العظمى من مشاكل
كثيرة لا يمكن أن تعالجها سياسة العنجهية التي تعودت انتهاجها والهرب
للأمام في الأزمات لحفظ ماء الوجه.
في الوقت نفسه
تطالعنا بعض وسائل الإعلام بمادة إعلامية فيها من قصر النظر والمنطق
التسطيحي للأمور ما لا يمكن السكوت عنه. خاصة وأن في ذلك عامل إضافي وأساسي
من عوامل تهييج العنف الكامن عند الأفراد والجماعات الذين يشعرون أنهم
مستهدفين دون أن يكون لهم أي باع في ما يحصل لهم أو حولهم.
كما هو ملاحظ
في الأزمات، بدلا من التمعن بالأسباب الحقيقية لما يجري والسعي المسؤول
والدؤوب لمعالجته، يتم انتهاج سلوك لا عقلاني يقوم على نقل الذنب للآخر
الذي يغدو الضحية بامتياز. كان من الأجدر الرجوع لبرهة لمساءلة الذات في ما
اقترفت اليدان من ذنوب أدت لتفاعلات يائسة وخيارات لا عقلانية. وكان من
الأفضل التعمق في مسببات الظواهر التي يتوقف عندها العالم اليوم، واعتماد
سياسات مواجهة ذكية ومتعددة الميادين في علاجها بدلا من صب الزيت على النار
ومقابلة الكيل بكيلين.
إن ما يزيد من
شحنات التوتر والتأزم في العلاقات بين البشر هو هذا الجهل بالآخر، عند من
يتحكمون بموازين القوى الدولية، والعبث بحقوقه وقصر النظر في التعاطي مع
قضاياه. مما يمهد للعنف المضاد الذي لا يمكن السيطرة على تعبيراته عندما
يتغذى من الإحباط والإحساس بالظلم وانعدام العدالة وانتفاء المحاسبة. إن
السهولة في إعزاء الكل إلى الجزء وتعميم الجزء على الكل إنما تنم عن مشكلة
تقبع حكما في الذات وليس بالضرورة عند الآخر الذي يلعب دور مرآة الذات.
ففترات الأزمات تترافق بأزمة على صعيد الهوية الشخصية، حيث الشعور بانعدام
الأمان، جراء إحباطات الحاضر والخوف مما يحمله المستقبل، يعزز القلق
المعشعش في زوايا النفس البشرية. فهو يحملها، في محاولة لترسيخ الشعور
بعالم داخلي آمن، للبحث عن كبش محرقة تسقط عليه ما في داخلها من مشاعر
سلبية لا تقبلها. والمرء بحاجة أن يتميز عن غيره، خاصة عمن يكون على مسافة
قريبة منه، بالعمل على جعل المسافة أكبر. مما يوهمه ببعض شعور بالاطمئنان،
في حنين لعالم ولىّ فيه من نسج الخيال ما يجعله أقرب للحلم منه للواقع.
الخطر الأكبر
هو في وجود مشاعر عنصرية من هذا النوع عند الذين يتحكمون بمقادير الجماعات
والشعوب. ذلك كونها تشرّع للعنف وتبرر انفلات التصرفات الغريزية من عقالها،
مستهدفة من هم أضعف والذين ليسوا بالضرورة بعلاقة مع الحدث. في وضع كهذا،
تكفي كلمة غير مسؤولة لتأخذ أبعادا لا تحمد عقباها عندما يكون فيها تحريك
لمشاعر النبذ للآخر. مما يحاول تعطيل حوار الحضارات وإلغاء إسهامات الشعوب
في التراث الإنساني.
إن إدانة
الإرهاب ينبغي أن تكون إدانة كاملة ولا تتحمّل ملطّفات. فما من شيء يبرر
قتل البشر والتعدي على حقهم في الحياة. خاصة عندما يخول الجناة (أو الحكام)
لأنفسهم التصرف باسم الآخرين أو المصلحة الوطنية. والسؤال المطروح هو:
لماذا لم تتوصل المفوضية العليا لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة بالإرهاب إلى
مناقشة تعريف حقوقي لجريمة الإرهاب بعيدا عن المصالح السياسية الآنية لهذا
البلد أو ذاك؟ في القانون الإنساني الدولي يتمتع من يقاوم الاحتلال بحماية،
لكن ليس عندما يأخذ السلاح ويقتل المدنيين. لذلك ما زالت المجموعة الدولية
تجد صعوبة في تعريف الإرهاب بغياب الإجماع في الجدل السياسي حول هذا الشكل
من أعمال العنف الذي يعتبره البعض إرهابا والبعض الآخر أعمال مقاومة. لذا
بات من الضروري التوصل لفرض تعريف للإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مشروعية
المقاومة عندما تكون الأعمال موجهة لدولة محتلة من أجل تحرير الأراضي من
احتلالها وانتزاع السيادة والاستقلال. إن بذلك ما لا يسمح للولايات المتحدة
وغيرها اعتبار الذين يقامون إرهاب الدول إرهابيون، في الحين الذي تبيح
لنفسها إنزال العقوبات بهم وتساند الدولة التي احتلت بلدهم وأجبرتهم على
مقاومتها ولا تعتبرها إرهابية.
هل هناك مسؤول
أمريكي واحد يجرؤ على اعتبار نيلسون مانديلا إرهابيا وهو الذي تبنى العنف
للتخلص من نظام الأبارتايد ودفع الثمن 27 عاما من الاعتقال؟ للأسف، لم
يتوصل صانعو القرار على الصعيد العالمي لتحديد الفرق بين الضحية والجلاد.
فمصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية تمنعهم من الأخذ بعين الاعتبار للأسباب
الحقيقية للجوء إلى العنف في المجتمعات البشرية.
ألم يكن
الأمريكيون هم من تحالف مع بن لادن عندما كانت مصالح الطرفين تقضي بدحر
الاحتلال السوفياتي عن أفغانستان؟ ولماذا اعتبرت الولايات المتحدة محاربة
القوات السوفيتية فيها مقاومة ولا تعتبر مجابهة قوات الاحتلال الإسرائيلي
كذلك؟ "عندما وصل "الطالبان"، يقول الصحفي روبرت فيسك، وعلقوا على أعواد
المشانق كل معارض وقطعوا أيدي اللصوص ورجموا النساء بالحجارة بسبب الزنى،
اعتبرت الولايات المتحدة هذه الجماعة المرعبة قوة خاصة من أجل الاستقرار
بعد سنوات من الفوضى".
أولم تكن الدول
الغربية وأمريكا هي من تحالف مع صدام حسين وعززه بالأسلحة المتطورة ليدفع
بها عنهم القوة الصاعدة في إيران؟ استمر الأمر كذلك إلى أن وجدت الطريقة
لكسر شوكته بضرب البنية التحتية لبلده وتجويع وإبادة شعبه بحجة التخلص منه
والقضاء على حكمه بعدما قدم خدماته ولم تعد هذه الدول بحاجة له. في كلا
الحالتين، كان الاعتماد على التوجيه الإعلامي المفرط والضغط على الدول
واستعمال القوانين الدولية بما يخدم المعركة من خلال ما تراه الولايات
المتحدة مناسبا مع مصالحها. وكان قلب الصورة بين ليلة وضحاها ونقل الذنب
للآخر عبر حرب نفسية شرسة لتبرير ما يجري من أعمال عدوانية غايتها وضع اليد
على منابع الذهب الأسود.
واليوم عندما
يلجأ الطرف المستضعف لوسائل إعلامية يوصل عبرها ما يجري على أرض الواقع دون
أخذ أذن من الولايات المتحدة، ترتعد فرائصها محاولة النيل بكل الوسائل من
هذا الإعلام الذي ليس في خدمتها. من هنا، لابد بالمناسبة من التأكيد على
التضامن مع وسائل الإعلام هذه التي تلعب دورا بارزا على هذا الصعيد. نخص
بالذكر قناة الجزيرة التي، رغم نقاط الضعف التي تعاني منها والتي هي بعلاقة
مع البيئة التي تنطلق منها (كضعف نسبة الوجوه النسائية في برامجها)، لم
تسمح للحرب الإعلامية والنفسية الأمريكية أن تنجح هذه المرة كما نجحت أبان
حرب الخليج الثانية التي قادها بوش الأب.
إن عدم القدرة
على التعاطي مع العالم من خارج المصالح المباشرة والرؤية الضيقة لمجموعات
الضغط تعيد لذاكرتنا ما حصل خلال هذه الحرب وتستحثنا على عدم الوقوع مجددا
في مطبات وخيمة العواقب. فالمطلوب تدارك عقم هذه السياسات القائمة على منطق
الغلبة والقهر. سياسات تغذي بقاء أنظمة استبدادية تلبس عباءة الوطنية أو
الدين أو كلاهما وتجعل من اللاعقلانية القاسم المشترك الأعلى بين الأقوى
والأضعف.
تخطي الأزمات
وتفادي الانزلاق في مطباتها يكون بفهم أسبابها ومنطلقاتها. لذا على
الباحثين والمفكرين إسماع أصواتهم، وعلى وسائل الإعلام عدم حجب الآراء
المخالفة التي لا تهادن حتى عندما يتعلق الأمر بكشف عورات الذات. لقد بات
من الصعب السكوت أو التمادي في المشاركة في لعبة من يتحكم بموازين القوى
ويجير الحدث لمصالح ضيقة الأفق تخدم في النهاية أغراض الأصوليين والعنصريين
وذوي النزعات الباتولوجية وتكون شرا يتحمل نتائجه من لا علاقة له به من بني
البشر.
الإرهاب هو ليس
فقط ما يقوم به بعض الأشرار أو الجماعات الأصولية أو الأفراد الذين اعتبروا
إرهابيين. إنه أيضا الإرهاب الفكري الذي غالبا ما تلجأ له الدول وبوسائل
أشد تأثيرا وظلما للحصول على ما تريد. يؤدلج ذلك في إطار خدمة مصالح هذه
الدول أو الطغم الحاكمة التي تخلط بين مصالحها الشخصية للبقاء في السلطة
وبين ما هو فعلا في مصلحة الدولة التي اغتصبتها لنفسها.
باللجوء لبعض
الأساليب والاستراتيجيات التي ثبت تأثيرها في حقل علم النفس الاجتماعي، ومن
خلال التجارب على بشر كانوا يعتقدون أنهم يملكون ملء حريتهم في اتخاذ
مواقفهم، بان أن هذه الحرية لم تكن سوى نسبية أو بالأحرى مزيفة. فقد فعل
هؤلاء ما كان يراد لهم أن يفعلوا من قبل آخرين، لهم بعض نفوذ ومشروعية في
التحكم بهم. حتى عندما كان المطلوب عكس ما يعتقدون أو ما يمكن أن يضر بهم
في نهاية المطاف. أكثر من ذلك، أثبتت هذه الأبحاث أن البشر، وبدافع الحاجة
للشعور بالانسجام مع النفس، يمكنهم أن يصروا على مواقفهم التي سبق واتخذوها
حتى ولو لم ترتكز على أسس سليمة. وحتى لو كان فيها مسؤولية كبيرة، كأن
يتعلق الأمر مثلا باتخاذ قرارات سياسية أو عسكرية أو مالية. فهل بعد ذلك
نفاجأ كيف أن الأفراد أو الجماعات يمكن أن تقاد إلى حتفها من قبل ساستها أو
القيمين على أمورها وتعمل ما يراد لها أن تفعله وتقبل جرها لمواقع ما كانت
لتلجأ لها بمفردها ؟
استطرد من ذلك
للقول بأنه أصبح متداولا الاعتماد على روائز لقياس الإمكانات العقلية
والمواصفات النفسية عند طالبي العمل لمعرفة مدى مطابقتهم للوظيفة المطروحة
وانتقاء الأفضل منهم. أليس من الضروري اعتماد نفس الأسلوب لاختيار الأشخاص
الذين يتولون مقادير الشعوب، وبالأخص أولئك الذين يتحكمون بموازين قوى
واسعة التأثير ؟ لو حصل ذلك لما وصل تردي الأوضاع لما هو عليه اليوم.
إن المسؤولية
في تفشي الإرهاب مسؤولية جماعية وليست فردية. إنها مسؤولية الكبير قبل
الصغير، تنطلق من قمة الهرم الاجتماعي إلى قاعدته، في علاقة جدلية بين
السياسي والاجتماعي والأسري وبتفاعل يمكن أن يحول المقموع إلى قامع. يتعاظم
خطر المقموع عندما توضع بين يديه إمكانات كبيرة تخول له ارتكاب ما شاء من
فظائع تشفي غليله للانتقام مما عانى منه. الأخطر من ذلك هو عندما يغدو
استعماله الآخرين وإرغامهم بالترهيب والترغيب لتبني قراءته الذاتية للأمور
في خدمة مصالحه الشخصية مسألة اعتيادية ولو ألبسها حلة الموضوعية أو اختبأ
وراء المصلحة العامة. بقمعه للآخر يعيد إنتاج ما ارتكب بحقه في صغره في
تجاوب مع رغبات غير معلنة أو لا واعية أحيانا كثيرة. وبعلاقة مع ما توفر له
من مثل أعلى يحتذى، من الآباء والمدرسين إلى الحاكمين وذوي النفوذ وأية
سلطة تملك رمزيا مقومات المثل. من هنا ليس من المقبول تناول إرهاب الجماعات
فقط والتوقف عند حافة إرهاب الدول. فالأول ليس أكثر خطورة من الثاني وإنما
العكس. لكن المسألة تتعلق ببساطة بموازين قوى تملي على من عداها الوضع الذي
يلائمها. فشريعة الغاب تبيح للكبير أكل الصغير ولو كان ذلك على مستوى
الكائنات البشرية والمجتمعات الإنسانية.
كلنا مسؤول
إذن، وإن بدرجات متفاوتة، عما يجري من تزايد لأشكال العنف والإرهاب. فعملية
تراكم الإحباط تبدأ منذ الطفولة، من العلاقة مع الأب المتسلط وفي مناخ لا
تجد التربية المنزلية اللاديمقراطية أصواتا كثيرة تشكو منها بفعل التبريرات
التي يسوقها المجتمع، وكأن الراشدين ينسون ما عانوا منه وهم أطفالا. يتضاعف
الشعور بالغبن وفقدان الكرامة مع الحاكم المستبد الذي يعمل لضمان بقائه في
الحكم أطول مدة زمنية ممكنة. ويكون ذلك بخلق مناخ من غياب الحريات الأساسية
وتغييب المواطن واغتيال النهضة الثقافية وفشل السياسات التعليمية والبرامج
التنموية. في جو تعبق فيه رائحة فساد الأجهزة ونهب الأموال العامة لحساب
نخب عسكرية وأمنية وحزبية وفئوية أرادت لكلمة المجتمع المدني أن تكون
مصطلحا مستوردا وليس سلطة مضادة. القهر لا ينشأ فقط مع ما تفرضه القوى
العظمى والبلدان الصناعية من هيمنة على البلدان النامية. وليس فقط لأن
عالمنا مترابط ومتداخل تؤثر فيه أسواق البورصة دون حدود على مستوى معيشة
الناس ويترك النظام المالي العالمي بصماته فيه على برامج التنمية بتخفيض
مستوى معيشة الأضعف ورفع شأن ورفاهية الأقوى. الشعور بالإحباط والمرارة
يتأتى خاصة مع ما يفرضه حكام بلدان العالم الثالث على شعوبهم. هذه البلدان
التي لم تعرف بمعظمها آليات الانتقال الديمقراطي للحكم وإنما خبرت
الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها باتباع أساليب فيها من العنف وانتهاك
لحقوق المواطن ما يجعل من العنف مولدا لا محالة لعنف مضاد.
أليس باسم
الحفاظ على الأمن وعبر تطبيق القوانين يتم توقيف المعارضين للحكم في الدول
العربية وبالأخص تلك التي تحتل الصدارة في تطبيق الآلة البوليسية والقمعية
ضد المواطنين كسوريا أو تونس مثلا؟ لو كانت هذه المعارضة مسلحة وعنفية
لكانت التبريرات أسهل أن تقنع من لا يعرف بحقيقة الأمور، لكنها معارضة
سلمية سلاحها كلمتها وقلمها.
علينا البحث عن
أوجه الشبه بين العنف الممارس من قبل القوى العظمى على البلدان الضعيفة
والفقيرة وبين العنف المطبق من قبل السلطة الحاكمة على مواطنيها وفئاتها
المستضعفة واستعمال الترسانة العسكرية أو الأساليب المتاحة لإسكات الصوت
النشاز الذي يشكك بمشروعية الحاكم ويخيفه من فقدان امتيازاته. أوليس اللجوء
للعنف في هذه الحال أو تلك ما يفسر وجود رد فعل يتخذ أشكالا متنوعة للتعبير
عن الشعور بالظلم ومحاولة رفع المهانة واسترداد الحقوق؟
للقضاء على
مسببات العنف والإرهاب لا بد إذن من تغيير الزاوية التي يتم منها النظر
لهذه المسألة، وخاصة في هذا الظرف بالذات. فالحلول الأمنية والعسكرية
لتبرير مواجهة العنف والإرهاب ليست هي الحل. إن فيها بالأحرى ما يزيد من
سعيرها بدل أن يعمل على اجتذاذ جذورها. صحيح أن القانون يجب أن يطبق على
الجناة لما ارتكبوا من أفعال بهدف الحفاظ على النظام ولحمايتهم من أنفسهم
وحماية الآخرين مما تجني يداهم. لكن المشكلة تبقى في كيفية استعمال
القانون وطريقة تطبيقه وفي التفسيرات والتبريرات التي تعطى لذلك من طرف
الفئة الغالبة ضد الطرف المستضعف والمغلوب على أمره.
انفتاح العالم
على بعضه أصبح يتطلب أكثر من ذي مضى التخلي عن التفرد والانطوائية- التي قد
تكون في ناحية منها رد على العولمة الزاحفة بشكلها الحالي. ولا شك بأن
الجواب الأفضل على التغييرات السريعة والتطورات الكبيرة التي تحصل في عالم
اليوم هو امتلاك هوية عابرة للحدود، همها كرامة الآخر وضمان حقوقه. إن في
ذلك وحده الضمانة الأكيدة لكرامة الذات وحفظ حقوقها وليس العكس.
أطفال الانتفاضة
ما كادت الحرب
العالمية الثانية تضع أوزارها إلا وعادت النزاعات المسلحة من جديد تلقي
بأهوالها على العالم حيث نشب ما لا يقل عن 149 حربا بين عام 1945 و1992
(بينما لم تعرف البشرية من مطلع القرن حتى الحرب الكونية الثانية سوى 88
حربا). وقد أدت هذه الحروب لمصرع 23 مليون شخصا، أي بمعدل ضعف وفيات القرن
التاسع برمته وسبعة أضعاف القرن الثامن عشر.
إن ما يسمى
بالنظام الدولي الجديد، الذي لم يعمل على رأب الصدع بين أجزاء العالم
الغنية والفقيرة بما يخص المساواة والشرعية والهوية، قام على العكس من ذلك
"بشرعنة" ممارسة الانتهاكات. كما أن انتهاء مرحلة الحرب الباردة وأفول
الاتحاد السوفياتي سهّل للقوة العظمى لعب دور الشرطي العالمي، ضمن ازدواجية
صارخة في المعايير وعدم احترام قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
والقانون الدولي الإنساني. لقد نمت أجيال متعددة في جو من الحروب
والصراعات، حيث أنه أحيانا ما كان يتبع التوصل للسلم معاودة القتال أو
الالتحام من جديد أو التعايش القلق في ظل اللاسلم واللاحرب.
لمضاعفة الآثار
الجانبية للحرب، تلجأ القوى المتحاربة من جملة ما تقوم به لتدمير البنى
التحتية للخصم، خاصة عندما يكون الهدف الإبادة الجماعية. بما يلغي الفروق
بين الجنود والمدنيين- بين1980 و1990 مثلا، 80% من الضحايا كانوا من
المدنيين ولأول مرة في التاريخ خاض حلف شمال الأطلسي حرب الكوسوفو بنسبة
صفر بالمائة من الخسائر في أرواح عسكرييه- كما يجبر على النزوح واللجوء،
فيما يساهم بتمزيق العلاقات الاجتماعية والروابط العائلية. تصاحب الحروب
حالات سوء تغذية متزايدة بسبب تعطل عمليات الإنتاج والتوزيع وقطع إمدادات
المياه وتلويثها. كما يرافقها أعمال إجرامية من اغتصاب وتعذيب وانفصال
الأطفال عن ذويهم، بما يرفع من معدلات وفياتهم عشرات الأضعاف.
مضاعفات هذه
الحروب كبيرة أيضا على الأجيال القادمة، بالأخص في البلدان النامية (سنة
1993 كان هناك 79 بلدا يعانون من صراعات كبرى أو أشكال من العنف السياسي،
65 منهم بلدان نامية). فهي، بعد توقف استنزاف مواردها، عليها بناء ما تهدم
واللحاق بمسيرة التطور بحشد طاقاتها لسنوات طويلة. هذا في حال أتيحت
لطاقاتها البشرية فرصة أخذ مكانها في عملية التنمية والبناء. خاصة وأن
السلطات التي تقوم بحجة أو ضمن سيرورة الحرب، غالبا ما تضرب الحريات العامة
باسم الخطر الخارجي وتتعامل مع شعوبها من باب القمع والإلغاء أو التهميش
بدلا من أن تترك لها فرصها بالتعبير عن نفسها والمشاركة في القرار.
يلاحظ أن الدول
الأكثر فقرا هي التي تنفق على التسلح أكثر من إنفاقها على التعليم والصحة.
لكن لو أعيد توجيه ربع ما تنفقه هذه الدول على التسلح، فان هذا يكفي لتوفير
الموارد الإضافية اللازمة من أجل الحفاظ على الحق في الحياة للأطفال وتحقيق
الأهداف التي حددت للعام ألفين بما يخص الطفولة. ذلك بتأمين الرعاية الصحية
لهم وحماية البيئة الأسرية والقضاء على سوء التغذية وتوفير مياه شرب نظيفة
وتوفير التعليم الأساسي وتخفيض الأمية وتنظيم الأسرة وحظر المعاملة السيئة
وغيره من ضمانات طالبت بها اتفاقية حقوق الطفل تنطبق في وقت السلم كما في
وقت الحرب.
لم يعد أحد
يقول اليوم بأن الحرب هي الوسيلة العنيفة لممارسة السياسة. فمصطلح الحرب لا
يتعلق فحسب بحركة الجيش صوب من يعتبره عدوا له. إن حصار المدنيين هو إعلان
لحالة الحرب، الاستيطان في أرض محتلة هو جريمة ضد الإنسانية وحالة حرب على
حقوق شعب وبالتالي حرب على شعب. تهجير السكان من أرضهم هو إعلان حالة حرب.
من هذا المنظور الذي يتفق عليه حقوقيو القانون الدولي، فإن دولة إسرائيل
تخوض منذ قيامها حربا مستمرة ضد الشعب الفلسطيني بالمعنى الواسع للكلمة.
حربا منهجية في الأراضي المحتلة بعد الخامس من حزيران (يونيو) 1967 إذا ما
اعتمدنا على قرارات مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعين
للأمم المتحدة. عندما تفرض دولة مستعمرة عالية التسلح على مجتمع شبه أعزل
حربا شاملة تستهدف وجوده وهويته وكيانه ومستقبله، فمن حق هذا المجتمع أن
يواجه دولة الاحتلال باللجوء لأساليب النضال التي تحول دون حرمانه من حقوقه
الأساسية. ومن المفترض إذا ما اقتنع بأن الصحة العقلية والجسدية للبشر قضية
جوهرية في المقاومة، أن يلجأ لاستراتيجيات نفسية واجتماعية، إضافة
للسياسية، تؤمن حمايته.
يهمنا هنا
التركيز على تأثير النزاعات المسلحة على الأوضاع النفسية للمدنيين وبالأخص
فئة الأطفال منهم (هذه التسمية تشمل فئة الشبان أيضا حيث تحدد الاتفاقية
الدولية لحقوق الطفل العمر الأقصى ب18 سنة). إن التعرض، خاصة طويل الأمد،
للصدمات والقلق والضغط من جراء الحرب، يترك بصماته على البناء العقلي
والنفسي وأحيانا الجسدي للطفل. فالحرب لا تهدف فحسب لتشويه الجسد، وإنما
الطاقات العقلية والنفسية للآخر. وعليه، فإن البقاء على قيد الحياة مرهون
إلى حد كبير بالقدرة على الحفاظ على النفس بما تتطلبه من إمكانات ليس فقط
جسمية وإنما أيضا عقلية ونفسية..
لم يتفق جميع
علماء النفس، الذين بحثوا عن تأثيرات الحروب على الأطفال وتوصلنا
لدراساتهم، في مجمل الاستنتاجات التي خلصوا إليها. فهذا يتعلق بإشكالات
تقنية لسنا بصددها الآن. إلى جانب ذلك كان التركيز على المدى القصير أكثر
منه على متابعة الحالات على المدى الطويل. لكن من المسائل الأساسية التي
اتفقوا عليها : الدور الرئيسي الذي تلعبه البيئة المحيطة في حماية الطفل
وصحة بنيانه النفسي والعقلي والجسدي. ذلك، خاصة في السنوات الأولى من عمره،
حيث يعيش الأحداث ويتعرف على العالم من خلال هذه البيئة. إنها بالدرجة
الأولى الأسرة، ثم تأتي فيما بعد المؤسسات الحكومية التي تعنى برعاية
الطفولة والشبيبة وكذلك جمعيات المجتمع المدني المختصة إن وجدت. وبما أن
الأسرة هي مركز الثقل الأساسي، وبالأخص الأم بسبب قربها الكبير من أبنائها
وتأثيرها الشديد عليهم خاصة في مراحل الطفولة الأولى، فعلى العناصر الأخرى
التي هي جزء فاعل في هذا المحيط مساعدتها للقيام بأعبائها. لقد أظهرت
الأبحاث أهمية دور الأم وانعكاس توازنها النفسي وتماسك شخصيتها وقوة قدرتها
على الاحتمال والصمود وامتصاص الصدمات، إيجابا على حماية أطفالها من
تأثيرات الحرب وأهوالها.
هذا لا ينفي
بالطبع دور شخصية الطفل وتأثير الصفات التي يتميز بها سلبا أو إيجابا على
ردود أفعاله إزاء الصدمات التي تواجهه. من هنا، فكل حالة هي حالة خاصة لا
تسمح بالتعميم ولا بإطلاق التنبؤات جزافا. فالأطفال يتباينون فيما بينهم في
قدرتهم على مواجهة الخطر دون إلحاق الأذى الشديد بأنفسهم .
بغض النظر عن
وجود اختلافات في المواقف من الأحداث وفي طريقة قراءتها وبغض النظر عن
أهمية التأثيرات النفسية لما يجري اليوم على الساحة الفلسطينية على المدى
الطويل، فإن ما نراه عند أطفال الانتفاضة العزل ومواجهتهم للجيش الإسرائيلي
المدجج بالسلاح بشجاعة وتصميم ما يؤكد على أنه بالإمكان التأقلم مع الحروب
وأهوالها وبأن الموت احتمال يمكن التعايش معه عند شبان في مقتبل العمر. ذلك
أن في التعرض للأخطار ومقارعة الموت ما يؤكد على أهمية الحياة في ظل الحرية
والكرامة. فحالة الاستلاب الرئيسية لا تأتي من مشاركة الطفل والشاب في
الدفاع عن حقوق الجماعة وإنما من سلب المحتل للطفل الفلسطيني من أهم حقوقه
الفردية والجماعية. وبهذه المشاركة ما يحّول الشاب في نظر نفسه والعالم من
حوله من وضع الضحية المسحوقة إلى شئ آخر ذو قيمة. فيما يقوي من معنوياته
وثقته بنفسه ويزيد من قدرته على الاحتمال والصمود في مواجهة الآلية
العسكرية الإسرائيلية وموقف الرأي العام العالمي من قضيته. إن استتباب
الأمن بالنسبة للطفل الفلسطيني هو استتباب الاحتلال، والسلام الذي قّدم له
إنما هو كلمة مفرّغة من معناها لا ترد حقوقا ولا تمنح عدالة.
بالمقابل، يبدو
الإسرائيليون اليوم، أو على الأقل بقسم كبير منهم، وكأنهم لم يستفيدوا من
دروس معاناة اليهود على يد النازيين وما خلقت هذه التجربة من روح مقاومة
وتضامن. ولم يفهموا أن ما فرضوه بدورهم على ضحاياهم يمكن أن ينتج عنه عند
هؤلاء ردود فعل مشابهة. فهم ليسوا فئة متميزة عن غيرها، ومعروف أن الآليات
النفسية الأساسية التي تتحكم بالإنسان لا تختلف من عرق لآخر أو دين لآخر.
كما أن عدوانية المرء تتأثر بعدوانية الآخر في الجهة المواجهة، خاصة عندما
لا تخضع تصرفات هذا الآخر لمنطق المحاسبة.
يمكننا إذن أن
نسلم جدلا بوجود عامل التأقلم مع الحرب، وبأن الفعل في الأحداث يقلل من
التوتر الناتج عن هذا الوضع بتحويله لشئ آخر، وبأن مواجهة الخطر تفترض
صلابة أكبر عند من يواجه ويشارك من ذلك الذي لا يساهم بها ويكون ضحيتها.
لكن هذا لا يسمح لنا بالقول أن الحرب لا تؤثر سلبا على من يعيش في ظلها
ويحرم لفترة زمنية قد تطول أو تقصر من مقومات الحياة التي يجب أن تتوفر
لبني البشر، وبشكل خاص الأطفال. هناك وضع يصعب تحمله قد فرض على الأطفال
الفلسطينيين بحيث لم يبق لهم من خيار سوى مواجهته. لكن لا يمكن بأي حال غض
الطرف عما يحمله تراكم الأحداث نتيجة هذا الوضع من تأثيرات على حالتهم
النفسية وقدرتهم على الاحتمال. إن كل يوم يمر يحمل معه عددا أكبر من
الضحايا بينهم. إضافة لمشاكل جانبية عديدة تنتج عن الإعاقة والمرض والحرمان
من الدواء والغذاء وإلى ما هنالك من أشياء لا يمكن أن تحصى مع الحصار
المضروب على الشعب الفلسطيني.
لقد استطاع
أطفال الانتفاضة بلجوئهم للحجارة من أجل الدفاع عن كرامتهم أن يعدّلوا في
موازين القوى. لكن حتى متى يمكنهم أن يصمدوا على هذا الشكل دون أن يكون
الثمن المدفوع أغلى مما نتصور ؟ لقد سمحوا بعملهم هذا لشرائح واسعة جدا في
العالم العربي أن تجد نفسها فيهم وأن تتفاعل معهم وتطالبهم بالاستمرار
والصمود في وجه الجيش المحتل. لكن هل يحق لنا نحن الذين نراهم على شاشات
التلفزة ونسمع عن بطولاتهم أن نكتفي بتأييدهم والتعاطف معهم وأحيانا النزول
في مظاهرات هائجة للتعبير عن غضبنا من حكامنا وتضامننا معهم وإدانتنا
للمحتل ؟ هناك أشكال كثيرة لمساعدتهم، وهي رغم أهمية ما حدث ليست معنوية
فقط. كل فرد يمكنه أن يفعل شيئا لو حوّل نقمته لفعل وترجمها على أرض
الواقع. والعبرة والذكاء السياسيين يكمنان في إمكانية استغلال الرصيد
المتأتي من أهمية رمزية تضامن الشارع العربي مع أطفال الحجارة.
عدد من هؤلاء
الأطفال لا بد يشعر بالمرارة والشك والخوف والقنوط والتعب وغيره من مشاعر
سلبية بعد فترات الهيجان والغضب والأخذ بالثأر. وبعضهم يستفيق على كوابيس
ويرى أحلام رعب في لياليهم القصيرة التي لم تعد تعوضهم الراحة. أليس بينهم
من هو بحاجة لآذان صاغية وأطر حاضنة تعطيه الفرصة لإخراج ما تراكم في طيات
لاوعيه وما اختزنته ذاكرته، كي لا يبرز يوما ما إلى السطح في أشكال قد لا
تكون مقبولة اجتماعيا ؟ كثير منهم فقد أخا أو صديقا أو شخصا عزيزا رحل عنه
وهو بقربه في مواجهة المصفحة الإسرائيلية. إن ما يواجهه بعضهم يضاف لمرحلة
صعبة يعيشونها على الصعيد الشخصي والتي هي فترة المراهقة بكل ما تحمله من
تأزمات وإشكالات خاصة بها. فأين نحن منهم وهم يودعون طفولتهم التي لم يتسن
لهم أن يعيشوها كما يعيشها أبناء العالم المحمي من هذه الأوضاع غير
الإنسانية في ظل غياب العدالة ؟
لم يتعامل
المحتل الإسرائيلي يوما مع الطفل الفلسطيني كطفل مساو للطفل الإسرائيلي، بل
لم يساو يوما بين الإسرائيلي اليهودي والإسرائيلي العربي في فرص التعليم
والصحة والسكن والعمل. منذ البدء، كان على الفلسطيني أن يقبل وضعا دونيا أو
أن ينتفض. وباستثناء أوساط اليسار غير الصهيوني في إسرائيل، كان منطق
التفوق لليهودي الإسرائيلي منطقا سائدا سواء بمرجعية دينية أو علمانية.
وإلا كيف يمكن تفسير العدوانية المستقرة في قطاع غزة بفرض مستوطنات
إسرائيلية في المنطقة الأعلى كثافة بالسكان في العالم ؟ كيف يمكن تفسير
وجود الشارع الأنيق للمستوطن والشارع المحفّر للفلسطيني؟ كيف يمكن تفسير
الاستفزاز اليومي لسكان مدينة الخليل بزرع عدد من المستوطنين في قلب
المدينة؟ كيف يمكن قبول جيب قبر الصالح يوسف الذي نسب للنبي يوسف في مدينة
نابلس ؟ كيف يمكن قبول تقطيع الوجود الفلسطيني بالطرق والمستوطنات وجعله
سجونا جماعية في العراء ؟ كيف يمكن للطفل الفلسطيني أن يحلم في ظل كل هذه
الكوابيس إن لم يصنع بجسده والحجارة الحلم ؟
إن الشبيبة
العربية اليوم بحاجة إلى شحنة كبيرة من الشعور بالمسؤولية حتى لا يبقى
الطفل الفلسطيني وحيدا في معركته لمقارعة العنجهية الإسرائيلية. لقد كان
لهذا الطفل فضل زج عشرات الآلاف منها في العمل السياسي والهم الوطني. وكان
له الفضل في إعادة كرامة ضاعت في زوايا التسلط العربي. بإمكاننا أن نكتفي
بترديد الهتافات والشعارات وكلمات الإطراء والاعتزاز وما شابه، لكن من
الأجدى لو واكب الإنسان العربي الإنسان الفلسطيني في معركته من أجل قطيعة
ضرورية مع الاستبداد والتسلط. من أجل قطيعة ضرورية مع الهزائم المبكرة
للكبار الذين صمتوا أو أجبروا على الصمت.
إن دعم الطفل
الفلسطيني، ضحية العدوان، تتم خاصة بتحويل مقاومته للمستحيل إلى مقاومة غير
مستحيلة، ومواكبة نضاله بتشكيل لوبي مناهض للعدوان الإسرائيلي. تتم بمحاولة
اختراق المحافل الدولية، مناهضة التطبيع مع القاتل، تقديم كل ما هو ممكن
لصمود الطفولة في وجه الظلم. وهذا مرهون برصد الشارع العربي لإمكانياته حيث
عودنا الحكام على الإحباطات المتكررة. فعندما يكون هدف المحتل إلغاء وجود
الفلسطيني وهدر حقوقه، يصبح من الضروري لنزع منابع الإحباط والألم توسيع
جبهة مقاومة الاحتلال وتعزيز إمكانيات المقاومة للشارع الفلسطيني.
قبل أن يقرأ
الطفل الفلسطيني اتفاقية حقوق الطفل، وجه رسالة إلى كل أطفال العالم يقول
فيها: لم يعد لدي سوى الحجارة للحصول على حقوقي الفردية كطفل، وحقي الجماعي
كشعب، فأين شعوبكم من مساعدتي على استرداد حقوقي المهدورة ؟
جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين
تتحدث الجرائد
في الآونة الأخيرة عن عزم السلطات الفلسطينية على فتح ملفات المسؤولين في
إسرائيل والمطالبة بمحاكمتهم لما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
بحق الشعب الفلسطيني، وطلب تشكيل محكمة مختصة بذلك
ad hoc
أي محددة في الزمان والمكان والموضوع على غرار المحكمتين اللتين شكلتا
لمحاكمة مجرمي الحرب في روندا وفي يوغوسلافيا السابقة.
نتمنى لهذه
المبادرة أن تؤخذ بالجدية المطلوبة ولا تبقى في إطار الكلام من أجل محاسبة
الكيان الاستيطاني الإسرائيلي على جرائمه التي ما فتئ يرتكبها منذ وجد
والتي تفاقمت حدتها مع تصعيد عملياته منذ انتفاضة الأقصى. فالمحكمة
الجنائية الدولية التي شكلت في روما لسنتين خلت وبالتحديد في تموز/يوليو
1998 ، والتي فرضت وجودها الحاجة الملحة في إنشاء هيئة قضائية دولية مختصة
بكبائر الجرائم التي تهدد النوع البشري، قد دخلت حيز التنفيذ. بعد أن صدّق
على ميثاقها أكثر من ستين دولة على الأقل. وبالرغم من أن صيغتها الحالية،
والتي وإن خرجت صيغة محسنة ومتطورة بالنسبة لما سبقها من ديباجات في
إتفاقيات جنيف الأربعة أو محكمة نورنبرغ أو غيره، لا تعدو كونها أكثر من حل
وسط بين أنصار محكمة قوية تتمتع بصلاحيات واسعة ودرجة كبيرة من الاستقلالية
وأولئك الذين يريدونها ضعيفة خاضعة لمجلس الأمن الدولي الذي يعكس هيمنة
الدول الخمس دائمة العضوية فيه وبالتالي أسبقية الدول على الأفراد والشعوب
وحقوقهم الإنسانية.
هذه الصيغة بدت
وكأنها ترهب البلدان التي لم تصدّق عليها والتي تتخوف من فكرة وجود جسم
قضائي يخرج عن سيطرتها ويمكنه محاسبة مسؤوليها المتورطين في جرائم متعلقة
بحقوق الإنسان : جرائم انتهاك دساتير بلدانهم أو تعطيل العمل بها، سوء
استخدام السلطة، ممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي، اغتيال المعارضين
والخصوم السياسيين وإلى ما هنالك من مسائل يمكن أن يحاسبوا عليها كالرشوة
والفساد وغيره. بالطبع من هذه البلدان التي لم تصدّق بعد على ميثاق المحكمة
الجنائية الدولية جملة البلدان العربية ما خلا الأردن وجيبوتي.
وكون إسرائيل
لم تصدق على المحكمة الجنائية الدولية، وبانتظار الوقت الذي يصبح للفلسطيني
الكيان السياسي الذي يسمح له بأن يصدق على اتفاقية روما، هذا إن لم يكن من
شروط الولايات المتحدة للدولة الفلسطينية المنتظرة أن تعطي الأولوية
للاتفاقيات الثنائية مع الإدارة الأمريكية على الاتفاقيات والمعاهدات
الدولية، لا بد من البحث عن صيغ أخرى لمعاقبة من ارتكبوا في الحكومات
الإسرائيلية المتتالية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه جيرانهم العرب
وبخاصة الشعب الفلسطيني. هذا الشعب الذي ما زال يعاني منذ نصف قرن ونيف من
ممارساتهم بحقه أغلبية الجرائم التي أحصتها المحكمة الجنائية سواء صنّفت
جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. فجرائم الحرب، كما وردت في موسوعة
الإمعان في حقوق الإنسان، هي مثلا الهجوم المتعمد ضد السكان المدنيين أو ضد
أفراد لا علاقة لهم بالأعمال العدائية أو الهجوم على منشآت مدنية لا تشكل
أهدافا عسكرية أو قصف القرى والأبنية الخالية من وسائل الدفاع وتحطيم
ممتلكات الخصم دون أن يكون هناك حاجة عسكرية لذلك واستعمال الأسلحة السامة
والهجوم على الأبنية والمعدات الطبية ووحدات النقل، الخ. أما الجرائم ضد
الإنسانية فمنها الاعتداء المنهجي والمتعمد والممارس على نطاق واسع على
المدنيين واللجوء لتعذيبهم وانتزاع الأراضي من أصحابها الأصليين وضمها ووضع
سكان مكانهم وتشييد نظام الفصل العنصري بينهم وحرمانهم من الحرية وكل ما
يسبب في إيذاء الجسد والنفس والصحة العقلية.
للأسف، رغم كل
الترسانات القانونية التي شكلت لصالح أعضاء الأسرة البشرية قاطبة لتفادي أن
تعلو المصالح السياسية على العدالة البشرية، ما زال قانون الغاب الذي يعطي
الأقوى الحق في البقاء والهيمنة ساريا وعلى نطاق دولي واسع. هناك ما يشبه
نظام الحماية الدولية لعدد من السياسيين أقوى من كل محاسبة. فمن يجرؤ اليوم
في الغرب مثلا على محاكمة شمعون بيريز على ارتكابه جريمة قانا في الجنوب
اللبناني وهو الحاصل على جائزة نوبل، أو مناحيم بيغن الذي نال نفس تلك
الجائزة ومسؤولياته في جرائم ضد الإنسانية يعرفها القاصي والداني ؟
إن الولايات
المتحدة، هذا الكيان الأخطبوطي الذي لا يأبه للقوانين والدولية عندما تهدد
مصالحه الاقتصادية والسياسية و"يشرعن" بالمقابل كل ما يمكن أن يخدم هذه
المصالح، ما زالت تدعم وبشكل سافر سياسات إسرائيل في المنطقة. نكتفي
بالإشارة هنا إلى أن المساعدة العسكرية التي قدمها هذا البلد للكيان
الصهيوني لمدة 30 سنة منذ 1967 تكفي لتأمين الماء الصالح للشرب والتعليم
الأولي لكل المحرومين منها على سطح البسيطة للفترة نفسها. كما أن حرب
الخليج التي استهدفت بلدا عربيا بالتدمير والإبادة فاقت تكاليفها المبلغ
اللازم لتوفير الحد المقبول للعيش لمن هم تحت خط الفقر في العالم الإسلامي
في الثمانينات والتسعينات.
أي سلام هذا
السلام الذي تتشدق به إسرائيل وهي التي كانت في الوقت نفسه الذي تجري فيه
مفاوضات وتوقع على اتفاقيات مع الفلسطينيين تهرع لزيادة مستوطناتها التي
زاد عددها منذ اتفاقية اوسلو بنسبة 52.49% وعدد مستوطنيها 52.96% ؟ إنها
ستبقى ماضية في غيها طالما بقي الموقف العربي والدولي غير متناسب مع ما
تفعله. لقد تصدت في وقت من الأوقات منظمات حقوق الإنسان لإسرائيل وطالبت
سويسرا الدولة الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع بمحاسبة إسرائيل على عدم
احترامها لهذه الاتفاقيات، فتدخلت عندها الولايات المتحدة ومنعت انعقاد
المؤتمر، ولم يكن يومها وكالعادة من رد فعل عربي يتناسب مع الحدث. كذلك
عادت بعد ذلك واستعملت حق النقض بهدف منع قوة مراقبة دولية من حماية
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
لقد كانت
اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد طالبت منذ سنتين في أول تقرير باللغة
العربية عن المحكمة الجنائية الدولية (أعده الدكتور محمد حافظ يعقوب)
بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ونحن نعتقد اليوم أن هناك ضرورة للتعبئة
من أجل انتزاع حماية دولية للفلسطينيين في لحظة يرتجف العالم الغربي فيها
أمام إقامة إسرائيل لجدار حماية مقتطع من الأراضي الفلسطينية. ومطالبة
الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية العليا للجنة حقوق الإنسان بالمبادرة
في فتح تحقيق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضد الإنسانية لكي لا يفقد
مكتب المفوضية آخر ورقة توت على جسد بذلك المنظمات غير الحكومية من أجل
قيامه الغالي والنفيس. وانطلاقا من اعتبار أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما
يمكنها من أجل وضع العصي في الدواليب في حال المطالبة بمقاضاة إسرائيل أمام
المحكمة الجنائية الدولية، واستعمال حق النقض والضغط على الأعضاء الآخرين
في مجلس الأمن لسد الطريق على سبل الالتفاف عن التصديق الإسرائيلي، يمكن
العمل لتشكيل محكمة مكونة من شخصيات حقوقية واعتبارية في العالم لمحاكمة
إسرائيل على جرائمها على غرار محكمة راسل التي شكلت من أجل فيتنام.
إن ما يجري في
الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات لحقوق وكرامة الإنسان الفلسطيني
وصل لحد لا يطاق، في الحين الذي تتباطأ فيه المساعدات الدولية وخاصة
العربية في الوصول إلى هذا الشعب الذي عانى أيضا من التشريد واللجوء والقمع
المفرط والتفريط بحقوقه أينما حلّ والذي لا يرى اليوم من حل للخروج من
الوضع الذي هو عليه سوى استمرار الانتفاضة.
ففي الوقت الذي
بلغ معدل البطالة في الأشهر الستة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
ما يزيد عن 45% ويعيش ثلث السكان، أي حوالي مليون نسمة، تحت خط الفقر وبأقل
من دولارين للفرد يوميا، لم تتلقى السلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية
غير الحكومية من البنك الإسلامي للتنمية سوى 10 ملايين دولار من ال290
مليون دولار التي استلمها. وذلك من أصل 697 مليون تعهدت بتحويلها له الدول
العربية التي أقرت في قمة القاهرة مساعدات بقيمة مليار دولار للشعب
الفلسطيني. كذلك الحال بالنسبة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
التي تواجه سنويا عجزا في ميزانيتها والذي قد يصل هذه السنة ل65 مليون
دولار سيضطرها إلى خفض الإمدادات الغذائية والرعاية التعليمية والصحية التي
تقدمها إلى 200 ألف عائلة فلسطينية في الأراضي المحتلة إذا استمر الوضع على
هذا النحو. هذا بالطبع عدا الخسائر الجمة التي لحقت بالاقتصاد والبنية
التحتية وغيره. فالأضرار التي لحقت بالأراضي المحتلة خلال الأشهر الأخيرة
تحتاج لخمسة سنوات لإصلاحها على حد تعبير رئيس الأونروا في الشرق الأدنى
بيتر هانس (القدس 12 آذار/مارس 2001)
فاجأني صمود
هؤلاء الأطفال والشباب الذين التقت بهم بعثتنا التي توجهت إلى الأراضي
المحتلة لمعاينة أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم الطبية. كان الجرحى الذين
التقينا بهم في المستشفيات والمعاقين في مركز أبو ريا يؤكدون لنا بأغلبيتهم
أنهم سيعودون لساحات المواجهة مع الجيش الإسرائيلي بعد شفائهم واسترداد
عافيتهم.
فأين نحن منهم
وماذا قدمنا لهم سوى الخطابات الرنانة والعواطف الجياشة بينما بقيت
الالتزامات والتعهدات حبرا على ورق ؟ ففي ظل وضع يزداد سوءا يوما بعد يوم
لا بد لضمان استمرارية العيش والحد الأدنى للخدمات الطبية من الاعتماد على
مصادر تمويل من أجل مواجهة المتطلبات الملحة واحتياجات الطوارئ التي تضاف
للاحتياجات الاعتيادية اليومية. كيف لهم أن يصمدوا لدحر الاحتلال الجاثم
كالكابوس على صدورهم وهم يعانون من العوز والجوع (كي لا نقل المجاعة التي
بفضل التكافل الفلسطيني لم تظهر بعد ولكنها ممكنة الحصول إن استمر الوضع
على هذا الشكل) والتعرض للعنف اليومي والعقاب الجماعي المتعدد الأشكال
وبشكل منهجي ومدروس وبالتالي الصدمات النفسية والعصبية وتدني كميات الأدوية
(التي يعود جزء منها لعدم تنفيذ الشركات والمستودعات الطبية لالتزاماتها
نتيجة عدم دفع مستحقاتها المالية) وتقلص العمليات الجراحية وانتشار الأمراض
المعدية (التي من أسبابها توقف برامج التطعيم في القرى النائية والمحاصرة
ومنع الفرق الطبية من الوصول إليها) وتفشي الأمراض المرتبطة بنقص المياه
وتلوثها وباستنشاق الغازات السامة (التي منها ما لم تعرف نوعيتها بعد وتبدو
وكأنها ألقيت لتجريبها على الفلسطينيين الذين تحولوا فوق ذلك لحقل تجارب
عند الإسرائيليين)، إضافة لليورانيوم المنضب الذي طالب فلسطينيون بشأنه
وزير الدفاع الإسرائيلي بكشف الأماكن التي ألقي فيها.
بعد نجاح نسبي
في بداية انتفاضة الأقصى في إيصال صوتهم للعالم ها هم الفلسطينيون يعانون
اليوم من جديد من تعتيم إعلامي يضاف لارتفاع متزايد في عدد الضحايا الذين
يسقطون ولوضع اقتصادي واجتماعي متدهور. فماذا يلزمنا أكثر من ذلك كي نتحرك
كل على مستواه ونلتفت إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني على كل الأصعدة وخاصة
الصحية والتعليمية والاقتصادية ويتعرض لعملية إبادة وإن كانت بطيئة لكنها
منهجية ومدروسة ؟ لقد أقرت قمة عمان الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين.
فهل ستكون مقرراتها كلاما في الفراغ كما عهدنا ؟ إنهم مطالبين من جملة ما
يطالبون به بعدم التصلب مع شعوبهم فيما يخص المسألة الفلسطينية والسماح لمن
أراد بزيارة الأراضي الفلسطينية للاطلاع عن كثب على أوضاع الفلسطينيين
ومساعدتهم بما تيسر لهم من إمكانيات. إن خوف العربي من تخوينه واتهامه
بالتطبيع وما شاكل يجعله بعيدا عما يجري في فلسطين اللهم إلا عبر ما تنقله
الفضائيات ووسائل الإعلام. هناك قلة تتجرأ على ذلك وبالتحديد من بين
الحاصلين على جنسيات أوروبية. فلماذا هذا الانفصام في المواقف وهل كتب لنا
أن نبقى مسيرين بقوة إرادة من لهم مصالح في تفتيتنا وشرذمتنا ؟ أما آن لنا
أن نستفيق من هذا الثبات ونخرج عن هذا النفاق مستعيدين كرامتنا من أجل
الدفع بمسيرة الديمقراطية إلى الأمام ؟
----------------
كتبت المقالة
قبل عامين وعدلت الفقرة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بما يتناسب مع
المستجدات.
قراءة نفسية في جريمة العدوان
لم يعد التحليل
الجزئي للظواهر والأحداث يكفي المتتبع للإحاطة بموضوع اهتمامه. والعولمة
رغم مصائبها المختلفة، فتحت المجال أكثر من ذي قبل للتصور المتعدد الميادين
ليحتل ما شغله التخصص من أجل التخصص في الثقافة البشرية المعاصرة. من هنا،
اخترنا تركيز هذه الملاحظات على الجانب النفسي دون غيره كبُعد هام من أبعاد
لا تكتمل الواحدة منها بمعزل عن الأخرى.
خلال المرحلة
السابقة للحرب، أُطلقت حملات إعلامية هادفة روجت لشعارات بغت التأثير على
الرأي العام العالمي وتأليبه ضد شعوب المنطقة العربية والدين الإسلامي
باستغلال أحداث 11 أيلول والاستفادة من الصدمة التي أحدثتها للأمريكيين
وللعالم. لكن بالرغم من أن هذه الحملات لم تنطلِ هذه المرة على الكثيرين،
لا بد من إلقاء الضوء على بعض ما تنم عنه هذه السلوكيات، تاركين جانباً
أغراض ودوافع جماعات الضغط المؤثرة في القرار والمحاور الأخرى التي تم
تناولها في غير مكان. لقد كشفت الحرب النفسية هذه التعاطي التبسيطي مع ما
يمس الثقافات الإسلامية والعربية وما سببه من ردود فعل حاقدة على من ينتمي
لها بمن فيهم مواطنون أمريكيون. أضف لذلك تلك السهولة في تعميم الجزء على
الكل والتعامل بالأحكام المسبقة والسقوط في منطق صراع الحضارات وكل ما
تفتقت به ذهنية أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها غير موضوعية وأحادية النظرة
تنطلق من الأنا في تقييم العالم.
إذا ما أوغلنا
في التحليل، وجدنا أن هذه الرؤى والسلوكيات نابعة من ذهنية باثولوجية (من
نوع الفصامية أو بشكل أعم الذهانية حسب معطيات علم النفس التحليلي). بمعنى
أن رؤية الشيء أو الآخر لا تخضع لمعطيات الواقع وإنما لآليات محددة، لا
واعية في غالبها، تقضي بالفصل ما بين وجهي الخير والشر والجيد والسيئ
للموضوع نفسه. فيعزى العنصر الإيجابي للنفس ويتم إسقاط ما في هذه النفس من
نوازع سلبية وغير مقبولة على الآخر المختلف والذي لا ينتمي للجماعة. أكثر
من ذلك، تذهب هذه الآليات الدفاعية إلى حد تجريد الآخر من صفاته الإنسانية
وإضفاء قيمة إيجابية إلى الأنا ولكل من ترتبط به ممن يشكل جزءاً من النحن.
بذلك يُتاح الانتماء لهوية جماعية مطمئنة، وتلبية الرغبة اللاواعية
بالاتحاد مع من كان يشكل مصدر قوة واطمئنان مهمته دفع القلق عن النفس.
وكلما ازدادت المسافة بين النحن والآخر؛ اطمأنت الأنا وخفّ قلقها، خاصة
عندما يشكل هذا الآخر بما يمتلكه من صفات وميزات تهديداً للأنا.
لكن اللجوء غير
العادي لمثل هذه الآليات الدفاعية يمكن أن يصبح مرضيا، خاصة عندما يعفي
النفس من الشعور بالذنب إزاء ما ترتكبه من آثام بحق هذا الآخر الذي يحمّل
المسئولية في ما يتعرض له من سلوكات مهينة له. وحيث من ميزات النحن في
المثل الذي يهمنا هنا الحضارة والشرعية والقانون والحرية والديمقراطية،
يغدو الآخر متوحشاً وليس مستبسلا للدفاع عن نفسه. وهو قاطع الألسنة،
الشيطاني الصفات والخطر المحدق بالإنسانية لاستعماله أسلحة الدمار الشامل
التي لا تتوفر لمن عداه (في حين أن قوات "الخير" الأمريكية التي استعملت
حتى اللحظة القنابل العنقودية والقنابل التي تنفجر جواً والقنابل
الإلكترومغناطيسية واليورانيوم المنضب والممنوعة دولياً تعمل لصالح
البشرية!).
إذا ما اعتبرنا
أن الهوية الشخصية تتكون بجزء منها من تكييف الفرد وفق نموذج ثقافي محدد
وبعلاقة مع الجماعة - المرجع، لا يمكننا بالمقابل أن نسلم مع من يذهب للقول
إن من ينتمون للمجتمعات العصرية المتطورة صناعيا وتقنيا واقتصاديا هم
مؤهلون أكثر من غيرهم أن يكونوا نقديين بخصوص ما يقدم لهم من نماذج وتصورات
وتفسيرات. فالفرد وإن أصبح بإمكانه أن يكون أكثر تفردا في هذه المجتمعات لا
يعني أن حسه النقدي بات بالضرورة ناضجا لدرجة تتوافق فيها أفعاله
واعتقاداته مع تطوره التكنولوجي. فالنموذج الثقافي المسئول عن تكييف الفرد
هو الذي يقدم فحوى المفاهيم والرؤية للعالم، بحيث يجعل هذه الرؤية أحيانا
كثيرة نمطية ومغايرة لواقع الآخر. ومن المعروف إننا نرى في هذا الواقع ما
نريده منه وليس كما هو حقيقة.
عدم الرغبة هذه
في الانفتاح على الآخر واكتشاف حقيقته بكل ما تحمله من تعقيدات وغنى وتنوع
تتأتى من تربية عائلية تسلطية لا تؤخذ فيها بالاعتبار الحاجات الأساسية
للفرد. ما يعزز الإنغلاق على النفس واللجوء لقيم الجماعة والتقيد بأعرافها
بدلا من تحقيق الذات والقبول بالحق بالتفرد انطلاقا من احترام الآخر
والاعتراف بحقه بالاختلاف.
مثل بسيط
نستقيه من الإعلام الأنكلوأمريكي والفضائيات الإقليمية لندلل على توقع أكثر
من محلل لبداية الحرب من ملاحظة التحول في الخطاب الإعلامي البريطاني 48
ساعة قبل نهاية الإنذار. وفي حين نشهد تقييدا إعلاميا كبيرا على من يرافق
القوات الأمريكية والبريطانية ومن يعمل من الكويت، نجد أن محطات عربية
وإيرانية من المنطقة أو أوروبا تعطي هامشا واسعا للتحليلات المباشرة لأوسع
قدر ممكن من الآراء. مع ذلك يجري التهجم عليها باعتبارها تظهر الأسرى
والجثث، في حين تعطي القوات الأمريكية الحق لنفسها في قصف مراكز الإعلام
لهذا الآخر وتغييب صوته نهائياً. فالحرية لا تمنح للبربري وإنما هي من
مزايا المتحضر الذي يفصّلها على مقاس مشاعر جمهوره وحلفائه.
يتيح لنا الغوص
في نوازع النفس البشرية فهم سلوكيات أولئك الذين يعتبرون أن قوتهم هي
المرجع الأساسي لعلاقتهم بحق الآخرين في الوجود والسيادة على أرضهم والتمتع
بخيراتها. فمن يرسم سياسات الشعوب والأمم هم في النهاية بشر كغيرهم ولهم
ماضيهم وتربيتهم الحافلة بعجرها وبجرها. والخطر كل الخطر عندما تختل موازين
القوى لصالح أشخاص ذوي بنى نفسية مشوهة أو ضعيفة لا يتحملون وجود قوى مضادة
تسائلهم فيما يفعلون أو تطالب بالاقتصاص منهم عندما يخالفون الأعراف
والقوانين ويرتكبون الجرائم. أشخاص يعتبرون أن العدوانية هي القانون الأهم
والأكثر تأثيراً في العلاقات بين البشر. لقد رأينا في التاريخ القريب إلى
أين وصل بشعوبهم وشعوب العالم أشخاص من أمثال هتلر أو ستالين وما شاكل.
تخلق عنجهية
وجبروت القوة العظمى في العالم حالة تعطي صاحب القرار "صلاحية" الاعتداء
باعتباره عملا تأديبيا للعصاة. وبالاستناد لقائمة المؤرخ وليام بلوم، نجد
أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت منذ الحرب العالمية الثانية بقصف
العديد من الدول مع ما حمله ذلك من ويلات ودمار للشعوب المستهدفة: الصين
(1945 - 1946)، الصين وكوريا (1950 - 1953)، غواتيمالا (1954)، اندونيسيا
(1958)، كوبا (1959 - 1960)، غواتيمالا (1960)، كونغو (1964)، البيرو
(1965)، لاوس (1964 - 1973)، فيتنام (1961 - 1973)، كمبوديا (1969 - 1970)،
غواتيمالا (1967 - 1969)، جزرغرناد (1983)، ليبيا (1986)، السلفادور
ونيكاراغوا (الثمانينات)، بنما (1989)، العراق (1991 - 1999)، السودان
وأفغانستان (1998)، يوغسلافيا السابقة (1999)، والعراق اليوم من جديد. ولنا
أن نتساءل معه إن كان بإمكان بلد من هذا النوع أن يحمل الديمقراطية للعالم،
موثّقين جوابه: "إحلال الديمقراطية لم يتم في أي بلد من هذه البلدان".
مع ذلك يبدو أن
هناك من يصر بالتعويل على ديمقراطية هذه الإدارة الأمريكية الأكثر تطرفا
ويمينية وعلى إنسانية السيد بوش وأعوانه من محافظين متصلبين (أمثال
رامسفيلد وإيفانس ورايس واشكروفت وفولف وتنيت وبيرل قبل أن يستقيل وغيرهم).
قد يجهل هؤلاء (ومنهم الحالمون والمغرر بهم والذين أوصلهم العنف الممارس
بحقهم إلى حالة عصاب شديدة انعدمت معها إمكانية التفكير الموضوعي) أن هذا
الرئيس عندما انتُخب حاكماً لولاية تكساس في 1994 و1998 كان ذلك بفضل قانون
يسمح باستعمال البندقية في الأماكن العامة بما فيها المدارس والمستشفيات.
كما وأنه في ظل حكمه تعدت في هذه الولاية نسبة الأحكام بالإعدام النسب
الأخرى لبقية الولايات. أضف لذلك أن موقفه كان قمعياً من المحكومين
بالإعدام حيث لم يكن لهم أي أمل بالعفو عنهم، رغم أن بينهم من كان براء من
التهم الموجهة له، منهم المدعوة كارلا توكر التي بقي مصراً على رفضه العفو
عنها رغم تدخل زعامات العالم بشأنها ومنهم البابا يوحنا بولص الثاني. لقد
وصلت به الصلافة لحد السخرية منها بتقليد صوتها عندما استغاثت به كي لا
يعدمها، ما يعطي صورة عن شخص مضطرب إن لم نقل عديم الإحساس بالمسئولية
والحساسية لمشكلات الآخرين. وهو عندما أصبح رئيساً لبلده لم يتردد البتة
بتعيين اشكروفت المحافظ جداً والناشط من أجل تطبيق حكم الإعدام وزيراً
للعدل. كذلك لم يتوانَ عن العمل لمنع الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب
والسفاح. وهذه المسلكيات ليست سوى غيض من فيض لرؤية للعالم وللعدالة لا
تعرف للعفو مكاناً.
المعطيات
المتوفرة لدينا عن سيرته تدل على شخص عابث بكل شيء، شبه معدوم الاطلاع
والثقافة. لم يكن يكترث بالتعرف على العالم وكان غباؤه واضحاً للعيان عندما
كان الصحفيون يطرحون عليه الأسئلة خلال حملاته الانتخابية. تحت تأثير جرعات
الكحول الكبيرة كان يظهر عصبية وغضباً جارفاً ويصبح عدوانياً وفظاً تجاه
محيطه مستعملاً كلمات نابية. يترافق ذلك بسلوكيات من نوع عدم الاهتمام
بالغير وتقلص الشعور بالمسئولية والخلل في الحكم وانعدام القدرة على النقد
الذاتي وقلة التركيز والانتباه ونقص الذاكرة.
عندما أصبح
فيما بعد رئيساً للولايات المتحدة، تم ذلك بفضل قرار المحكمة وليس أصوات
الناخبين. ما زاد من أزمة الثقة بالنفس عنده، إلى أن أتت أحداث 11 أيلول
لتجعل منه بين ليلة وضحاها الرئيس الأمريكي دون منازع. لقد لعب عامل الخوف
من هذا الآخر الشيطاني فعله بين مواطنيه، خاصة وأنه عرف كيف يستغل ذلك
لأبعد الحدود. كان من شأن موضوعات مثل محاربة الإرهاب وتعقب القاعدة وشيطنة
العراق ما أحرز تقدم حزبه في انتخابات الكونغرس، حيث من الأربعين نائباً
الذين دعمهم 35 منهم فازوا بها.
من الواضح أن
شخصاً كهذا يفتقد للإمكانيات الذاتية التي تؤهله لتحمل مسئوليات كبيرة من
هذا النوع. لكن فضل عائلته عليه كبير وبالأخص أبيه الذي كان يمدّه بالدعم
اللازم، حتى عندما أصبح مدير أعمال للشركات النفطية التي أنشأها. وكونه
إدارياً فاشلاً، لم يستطع أن يجني منها أرباحا إلا بالطرق الملتوية وغير
الشريفة وعن طريق الصفقات غير النظيفة والتسريبات التي يمكن أن يُحاكَم
عليها لو فتحت ملفاته.
إذا ما عدنا
للوراء وتقصينا ماضيه نجد صبياً يفضل لعب البوكر وشرب البيرة ورفقة الفتيات
على الاهتمام بالفضاء السياسي. ذلك رغم أنه منحدر من عائلة سياسية حيث جده
كان سيناتوراً وأبوه سفيراً ثم مدير مخابرات ونائب رئيس قبل أن يصبح رئيساً
لبلده. لقد كان بوش الابن فاشلاً في الدراسة ومدمناً مزمناً على الكحول حتى
سن الأربعين. ولا يبدو أن علاجاً نفسياً جديراً بالاسم قد استعمل لتخليصه
من هذه الآفة بشكل سليم، بل إنه سرعان ما التجأ للإيمان تعويضاً عن الكحول.
إنه لشيء
إيجابي أن يتمتع الإنسان بجانب روحي في شخصيته. لكن إذا ما ناقشنا هذه
المسألة بشكل تحليلي أبعد مما تنم عنه الظواهر نكتشف أشياء أخرى. في
الواقع، إن الإيمان بالله يعني ترسيخ مبادئ العفو والتسامح ومحبة الآخر
والتسامي الوجداني. لكن في هذه الحالة التي نتناولها هناك استعمال للدين
واجتزاء له بما يترك المجال لإطلاق المكبوتات الغريزية العدوانية الموجهة
للآخر بقصد تحطيمه عندما يعزى له نوايا عدوانية. ذلك ضمن آلية تعفيه من
المسئولية إزاء ما يقترفه بحقه من جرائم.
لن أتناول
الإدمان على الكحول من الزاوية الأخلاقية، فما يعنيني هنا هو نتائج سلوكية
من هذا النوع على الغير، أو بالأحرى ما تنم عنه، خاصة عندما يكون المعني في
موقع قرار ومسئولية بهذه الضخامة. انطلاقاً من المعطيات المتوفرة لدي لا
أملك تحديد طبيعة البناء السيكولوجي للرئيس بوش بشكل مؤكد (وأحتفظ لنفسي
بفرضيتي). فتعاطي الكحول المزمن يمكن أن نجده لدى أنواع عدة من الشخصيات.
يتراوح ذلك بين طرفي نقيض: من العصابية إلى الذهانية، مروراً بما بينهما أي
ما يسمى بالحدّية، كما ويرافق الشخصية السيكوباتية.
لكن أستطيع
القول إن الإدمان على الكحول مسلك ينتج عن علاقة غير سليمة بين الأهل
والطفل، خاصة الأم وذلك في مراحل الطفولة الأولى. أي عندما يمر الطفل
بمرحلة محددة من نموه أشد ما يكون فيها بحاجة للإشباع العاطفي الذي لم
يتوفر له كما يجب. فعندما يكبر يبقى ذلك الطفل قابعاً في أعماقه يستفيق عند
كل اهتزاز عاطفي مطالباً بما لم يلقَه خلال نشأته الأولى، ما ينتج عنه عدم
ثقة بالنفس وعدم رغبة في الانفتاح والإطلاع على العالم من حوله، وبالتالي
عدم القدرة على محبة الآخرين والنظرة المتفائلة للوجود وإلى ما هنالك من
نتائج سلبية عديدة.
فالمسلكيات
التي نعرفها عنه في صغره تؤكد هذا التحليل الذي يدعمه الالتجاء بعد ترك
الكحول للإيمان. فمع انتفاء الإمكانيات الذاتية (الداخلية) التي لم يُتَح
لها أن تتشكل أو أن تتقوى، هناك حاجة ماسة للاعتماد على وسيلة خارجية تشد
إزر النفس وتعطيها مؤقتاً القوة التي تنقصها. وظيفة هذه الوسيلة أو هذا
القرين ليس فقط تأمين الاعتماد عليها وإنما أيضاً توفير إمكانية الاتحاد
معها تجاوباً مع نوازع تكمن في اللاوعي والتي منها الدفاع عن النفس في
مواجهة الاكتئاب والإعياء النفسي.
من ناحية أخرى،
تبدو صورة الأب قوية في ذهن الابن. ولا بد أن الحرب التي أطلقها على العراق
تؤمّن في جانب منها منفعة ذاتية بعلاقة مع هذه النقطة. أعني الرغبة في
التأكيد على الذات بمواجهة صورة الأب الذي بات بإمكانه أن يفخر بابنه الذي
ذهب إلى حد إنجاز ما لم يكمله هو. وبذلك منفعة أخرى برد جزء من الدين له.
قد لا تكون صدفة أن نجد الأب يشغل اليوم منصباً في الشركة المسماة
carlyle
والتي
يظهر أن عقوداً قد أُبرمت معها لشراء أسلحة تستعملها القوات الأمريكية
المنتشرة في العراق.
هذا الضوء على
بعض النقاط المتعلقة بالجانب النفسي لأحد المسئولين عن قرار العدوان يجعلنا
لا نستغرب أن يستطيع بوش وإدارته بقراراتهم المتطرفة تعطيل مكتسبات عشرات
السنوات من القوانين الدولية. هذه الترسانة التي عملت البشرية إثر خروجها
من الحرب العالمية الثانية على وضعها لحماية الشعوب من نتائج الحروب التي
يمكن أن تشنها زمرة حاكمة في هذا العالم الذي ما زال رغم كل شيء يخضع
لشريعة الغاب ولهمجية الغرائز البشرية عندما تفلت من عقالها دون رادع أو
حسيب. ولهذا، لا بد من تصعيد وتيرة تحركات القوى المضادة لوقف امتداد أخطار
المسئولين عن هذه الحرب. ومن ثم الشروع بتوفير كل مستلزمات محاكمتهم على
جرائمهم وعدم فلاتهم من قبضة العدالة وقضاء القوانين الدولية المتعلقة
والتي يفترض أن تطبق على جميع البشر دون استثناء أو تمييز.
للأسف، لا
ينفرد هذا الشخص بمساوئ كان بالإمكان تجنب نتائجها لو وجدت الشعوب آليات
تضمن حمايتها من أولئك الذين يملكون زمام أمورها عندما لا تؤهلهم طاقاتهم
لذلك. ونتساءل لماذا عندما يتعلق الأمر مثلاً باختيار موظف في مؤسسة ما
تعمد هذه قبل كل شيء لمعرفة جوانب معينة من شخصيته تدل على مطابقة هذه
للعمل المطلوب؟ هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن هذا وذاك، خاصة أولئك
الموجودين في منطقتنا العربية الذين نصبوا لقيادة شئونها رغماً عن أنف هذه
الشعوب.
العدوان الفكري
يشكل العدوان
الفكري (أو الإرهاب الفكري كما هو شائع) واحدا من أبشع وسائل العدوان على
الكرامة الإنسانية. فهذا العدوان، يستهدف أهم فارق بين الإنسان والكائنات
الحية الأخرى، وهو من أهم الوسائل التي تسعى لقولبة الكائنات البشرية في
قطيع يسير وراء نمط معين أو يافطة محددة أو رأي متفوق. فالإنسان امتاز بحق
الخلاف وحق المناظرة وحق التعدد. وما من دين أو قومية طالبت بخبز موحد ولغة
موحدة وكائنات منمطة وقراءة وحيدة للماضي والحاضر والمستقبل. من هنا، خطورة
هذه الظاهرة، التي وإن كانت تعود لمحاكم التفتيش في القرون الوسطى
الأوربية، وتجلت مع عصر التنوير في موقف الموسوعيين من جان جاك روسو، وقد
عادت للظهور في المحاكمات الستالينية وأصاب فيروسها العديد من المثقفين
التقدميين وانتقلت عدواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى
الإيديولوجية الصهيونية التي تسعى بكل الوسائل لفرض قراءة خاصة للتاريخ
الفلسطيني والتاريخ اليهودي، وتسعى بكل الوسائل، لمنع أي نقاش موضوعي حول
كتابة التاريخ الأوربي المعاصر في واحدة من أهم لحظاته الظلامية: الحرب
العالمية الثانية.
لا يمكن لمناضل
حقوق إنسان يعيش في ظل النازية إلا أن يصرخ في وجه هتلر: "كل واحد منا
يهودي وغجري". كما أن واجب كل مناضل أن يصرخ اليوم بوجه آرييل شارون: "كل
واحد منا فلسطيني". المأساة التي يريد اللوبي الصهيوني فرضها على العالم،
هي أن الإبادة التي تعرض لها اليهود تجعل منهم موضوعا فوق النقاش وفوق
المحاسبة، لأن هذا النقاش والمحاسبة يمكن أن يوقظا شيطان معاداة السامية في
الغرب وأن يمهدا لإبادة جماعية جديدة. لذا علينا إغماض العين عما يحدث في
فلسطين، وقراءة التاريخ والواقع كما يقدمه لنا القديسون الجدد. وإلا،
فالتهم جاهزة: تحريفيون، معادون للسامية، أنصار إنكار المحرقة، أصدقاء
النازية الخ.
وقد تعرض أهم
رموز الفكر والأدب العربي المعروفين بالغرب والذين وقفوا بحزم ضد الصهيونية
لهذه الحملات مثل الشاعر محمود درويش ومفكرين مثل هيثم مناع ومنصف المرزوقي
ومحمد حافظ يعقوب والباحث أحمد المناعي. بل ونشأ اختصاص حديث في الآونة
الأخيرة، في محاولة لبعثرة جبهة مناهضة التطرف الصهيوني ومناصرة شعب فلسطين
في أوربة اسمه "رصد التحريفيين ومعادي السامية في العالم العربي". كان آخر
منتجاته "دراسة" حول هذه الفئة من المثقفين في تونس، أعدتها إحدى
الصهيونيات في الوسط اليساري.
إن هذا العدوان
الفكري تجاه حرية الرأي وحرية البحث وحرية نقد المشروع الصهيوني يشكل خطرا
على نمو الأفكار الديمقراطية في الأوساط العربية المهاجرة، ومن المؤسف، أن
هناك من "عرب الخدمات" من وضع نفسه في خدمة هؤلاء.
الغاية
الأساسية للعدوان الفكري هي إسكات الخصم وإجباره على طاعة الغالب والمعتدي،
وبهذا المعنى، يصبح من واجب الباحث النقدي والمناضل الصمت، ليس له الحق في
أن يكون شاهدا على عصره، وليس له الحق في تقييم الوجود المحيط به، وأخيرا
لا حق له بحلم التغيير.
رسالة إلى أخواتنا وأخوتنا في العراق
عندما طلب إلي
المشاركة في هذا العدد الأول من صحيفة "الفرات"، الذي أرجوه فاتحة خير على
الجميع، لم يكن أمامي سوى تلقف الفرصة للتعبير عن تضامني الشديد مع شعب
العراق في المحنة التي يعيشها. محنة امتدت طوال ثلاثة عقود في ظل نظام
شمولي دموي وتعمقت مع دخول قوات الاحتلال الأمريكية-البريطانية إلى العراق
مؤخرا.
هذا الواقع
المتردي يأتي على خلفية نظام تسلطي فشل فشلا ذريعا في مواجهة معركتي
التنمية والديمقراطية وشعب همش مدنيا ودوليا وانتهكت حقوقه جراء العسف
الداخلي والحصار الاقتصادي والهيمنة الخارجية. والعراق ليس سوى صورة مكبّرة
لما تعيشة المنطقة العربية برمتها.
داخليا، عاث
التجمع الحاكم فسادا وظلما من أجل البقاء في السلطة التي أخذها بالقوة أطول
مدة ممكنة. فاستأثر بثروات ومقدرات بلد يملك حضارة عريقة وثروات نفطية
ومعدنية وطاقات بشرية ما يؤهله لأن يحتل مرتبة عالية بين البلدان المتقدمة.
كان ذلك بالقفز فوق القانون وإحلال قوانينه هو المعتمدة على تغييب الرأي
الآخر وانتهاك حقوق المواطن. وكان القمع الأعمى لمن يقاوم مشيئة الحاكم
والقذف به لأقبية السجون واعتماد التصفية الجسدية والتهجير للخارج وإسكات
الرأي الحر الذي يطالب بالانفتاح الديمقراطي والتداول على السلطة والتعددية
الفكرية والعدل الاجتماعي وتوزيع الثروة. فاعتمد على المحسوبية الحزبية
والولاء العشائري والارتهان للمصالح بدلا من التعويل على الكفاءة العلمية
والخبرة المهنية والطاقات الخلاقة. مما غيب ولزمن طويل الكثير من القدرات
المبدعة التي يذخر بها هذا البلد، فلم يستفد منها وطنها ولا حتى البلدان
المستقبلة في معظم الأحيان.
أما خارجيا،
بدت الهيمنة بوجهها القبيح وبشكلها المباشر والفظ أكثر صلافة وعنجهية بعد
فترة حصار اقتصادي كان الأبشع في تاريخ البشرية. وقد خلّف جروحا عميقة في
الجسم العراقي منها ما لن يمحى مع الزمن وستدفع ثمنه الأجيال القادمة. وبعد
حربين مدمرتين، أتى العدوان الأخير بتحريض من لوبيات ضغط وأصحاب عقائد ترى
العالم من منظار مصلحي دوغمائي وتختبئ وراء واجهة في إدارة أمريكية وحكومة
بريطانية لا تتحلى بمواصفات القيادة من ذكاء وبعد نظر وحكمة بشئ. لقد
اعتمدت على تلفيق وقائع والاستفادة من نقاط ضعف قاتلة لنظام منبوذ لتحقيق
مكاسب سياسية آنية ومصالح اقتصادية معروفة للجميع. فضربت بعرض الحائط بما
يسمى بالضوابط الأخلاقية والقوانين الدولية وحقوق الشعوب. وهي الآن تتخبط
في خضم وضع متفجر تزداد فيه روح المقاومة يوما بعد يوم بعد أن بانت أكاذيب
من لم يأت ليحرر وإنما ليحتل ويمتص خيرات البلد. . لقد رأى من غُرر
بالشعارات وتفاءل بطيب النوايا أن الاحتلال لم ولن يكن يوما لإحلال
الديمقراطية. انتشار الفوضى وغياب الأمن وخراب الوضع الاقتصادي والتراجع
على كل المستويات لم يأتي بالصدفة ولو قبلنا بشئ من الخوف من الآخر والجهل
بتعقيدات تركيبته، ما حال دون معرفة كيفية التعامل معه.
لكن قصر النظر
السياسي هذا وهزالة البنية الذهنية-النفسية لهؤلاء الحكام ستكون نقمة
ووبالا ليس على العراق والمنطقة فقط وإنما أيضا على الشعوب التي خضعت
كالنعاج لأوامرها اللا إنسانية والتي ستستفيق من غفوتها وتكتشف أنه غرر بها
واقتيدت على أيديهم إلى حتفها.
إن الشعور
بالإحباط والظلم نتيجة التضليل وامتهان الكرامة وانتهاك الحقوق لا يمكن إلا
أن ينتج عنه رغبة بالمقاومة لرفع الضيم، ولو أن المعتدي يحرمه حتى من حقه
الأساسي هذا بالمقاومة. ذلك بقلب الصورة ووضع المعتدي في خانة الضحية
بإطلاق صفة الإرهابي على من يمارس واحدا من حقوق الإنسان التي شكلت القاعدة
الأساس للشرعة الدولية.
التغيير الجدي
لا يمكن أن يفرض من الخارج وإنما ينبع من نضج الأوضاع الداخلية، بحيث يترجم
الفكر والوعي لممارسات وسلوكيات تنسجم معه في ظروف موآتية. وهنا لا بد من
التمييز بين فئة عايشت الواقع المر عن كثب ولم تقبل بتدنيس كرامتها من قبل
النظام المخلوع، وأخرى عاشت أزمات على الصعيد الشخصي إن في الداخل أو في
الخارج وحولتها مرارة تجربتها لضحية غير قادرة على مناقشة الأمور بموضوعية.
نتج عن ذلك سلوكات تدميرية موجهة للآخر وللنفس وتصلب في طريقة التعاطي مع
الأمور نتيجة تشوه صورة الذات وفقدان القدرة على التسامي والخلق.
هذا التقييم
ينطبق على المثقف العربي بما لا يسمح بالتعميم في أي حال من الأحوال. إنه
من الأخطاء القاتلة لعملية الفهم التي تقضي على الحقيقة عندما تتوخى
التبسيط وتعميم الجزء على الكل. قلة قليلة هي التي دافعت عن نظام صدام حسين
لأسباب مصلحية، ومن التجني القول أن الذين لم يقبلوا بالاحتلال الأمريكي
يقفون بالضرورة في خندق النظام العراقي البائد. فالفصل بين الشعب والنظام
يبقى من البديهيات عند من وقف ضد هيمنة القرار الأمريكي على العراق وعلى
الوطن العربي. ومن لا يقبل بذلك فهو يشارك في الترويج لأطروحات هدفها زرع
الشقاق بين أبناء الأمة خدمة لمبدأ فرق تسد. من هذا المنطلق نوجه نداءنا
للأخوة العراقيين بالحكمة والاتزان في إطلاق الأحكام على عاهلها كي لا
يخسروا أصدقاءهم، وكي لا يتجنوا على إخوانهم العرب الذين لم يقفوا ضد
الاحتلال إلا دفاعا عن حقوق وكرامة المواطن العراقي والعربي.
باعتقادي أن
الشعوب المظلومة تملك من الطاقات الإبداعية ما بإمكانه أن يقلب رأسا على
عقب المخططات المرسومة من قبل تكتلات وحكومات متطرفة ومصلحية فاعلة على
الساحة الدولية في زمن ما. والخلل في التوازن لحساب قوى مهيمنة لا بد أن
يقابله ردود فعل تعيد هذا التوازن لصالح الفئات التي انتهكت حقوقها حتى ولو
استغرق ذلك بعض الوقت.
من هنا، للنخبة
العراقية دور طليعي في تقويم المسار واسترداد الحقوق المسلوبة واستتباب
الأمن وتأسيس نظام ديمقراطي غير مرهون بالهيمنة الخارجية. ذلك بمراجعة
الذات أولا وتحويل المعاناة لما فيه خير للنفس وللآخر وتجنب تحول العنف
الكامن لعنف مدمر. إن في الانخراط بأطر وتجمعات حزبية ومدنية استثمار
للطاقات الخلاقة في خدمة عملية البناء والتحول وتأسيس نظام ديمقراطي يعطي
المثل لجيرانه. فالمواطنون وفي أي موقع كانوا يملكون من القدرات ما يسمح
لهم بالمشاركة في القرار ويفرض عليهم أخذ المبادرة لذلك. إن الفعل الهادف
الذي تحفزه إرادة التغيير ووضوح الرؤيا وتقديم المصلحة الوطنية وابتكار
أساليب جديدة في الممارسة يحدث تراكمات تؤسس لقفزة نوعية لبناء المستقبل.
حول مفهوم الديمقراطية الحقيقية؟
ما من كلمة
عرفت هذا الكم من الملحقات مثل كلمة الديمقراطية. فهذا يتبعها بصفة شعبية
وذاك يختار تعبير ثورية وآخر يضيف جماهيرية.. الواقع أنه مع هجرة عدد من
الستالينيين إلى المعسكر الديمقراطي بدأ مصطلح "الديمقراطية الحقيقية"
بالبروز كرد على "الديمقراطيات الزائفة". وقد تنبه الشاعر جورج حنين لهذا
الفيروس الذي يصيب كلمة الديمقراطية فكتب في 1968: "يجب حشر الديمقراطية في
شئ ما، بل أن تختفي إذا أمكن فيه: إنها بداية كلمة مركبة. عندما يضاف إلى
ديمقراطية تعبير آخر تحت ادعاء توسيعها، يكون ذلك بمثابة اختزال لها إلى
مضمونها الأكثر استعبادا، وبمثابة زج لها في لائحة الألفاظ المبهمة
الدلالة. وهذه خاصية الاصطلاحية السياسية المعاصرة، القائمة على انتزاع قوة
النداء من كل كلمة حية.".
من الملاحظ أن
تعبير "الديمقراطية الحقيقية" بدأ مع شعور اتجاهات سياسية وحقوقية ومثقفة
بأن الحركة الإسلامية السياسية تشكل خطرا داهما وبديلا شبه جاهز للأنظمة
المتسلطة الهرمة. فهي تستفيد من عدة عوامل تسهّل مهمتها بينما حرمت منها
الأطراف الأخرى وهي: مكان اللقاء الإلزامي رغم حالات الطوارئ (المسجد)،
الثقافة الشعبية المتلقية بسهولة لكل ما هو ديني، الجانب التعبوي
والعاطفي، الخ. وقد روجت هذه الاتجاهات لفكرة أخرى مفادها أن استفادة
الإسلاميين من "السماح الديمقراطي" في بعض البلدان هو تكتيك آني لترسيخ
الأقدام بما يمكّن من التخلص من الأطراف الأخرى. ساعد على تعزيز وجهات
النظر هذه وجود اتجاهات استئصالية في الحركة الإسلامية السياسية نفسها،
برزت بشكل واضح في ما يعرف بسنوات الهبة الإسلامية (1978-1982) وشملت
أحزابا سنية وشيعية.
هكذا تعزز
اتجاه علماني استئصالي يقول بمبدأ "لا حرية لأعداء الحرية" ويصنف الحرية
والأحرار على هواه. كان هذا الاتجاه خير معين للمجالس العسكرية والأمنية في
عدة بلدان عربية وإسلامية. ذلك عند عملية ضربها للحركة الإسلامية بالوسائل
القمعية غير المسلحة (أبرز أمثلته في تونس ومصر) أو كما حدث في الجزائر،في
المواجهة المسلحة وشل العمل بالمؤسسات الانتخابية وبناء معسكرات الاعتقال
الجماعي والحرب الأهلية التي كلفت قرابة 180 ألف مواطن ومواطنة.
عندها برز
مصطلح الديمقراطيين الحقيقيين في تونس والجزائر. ثم لم يلبث أن انتقل
للمشرق، بادئ الأمر عبر بعض أشباه المختصين بالشرق الأوسط من قدماء "القوات
اللبنانية" الذين يقدمهم الإعلام الموالي للصهيونية باعتبارهم مختصين في
الشؤون الإسلامية.
لقد وقعت في
هذا الفخ عدة لجان دفاع عن حقوق الإنسان، ساهمت في تعبئة لوبي مناهض لحزب
الله والحركات الإسلامية في الكونغرس الأمريكي وروجت لأطروحة "التعددية
الديمقراطية" التي ترفض التعددية (حاف). أي تشترط أن يتوافق الآخر مع
تعريفها للديمقراطية وترفض السماح لأي حزب له طابع ديني بالتواجد. ذلك لأن
تواجده تعبير عن الطائفية السياسية التي تخالف "الديمقراطية الحقيقية"
والتي يمكن أن تقضي على الديمقراطيين الحقيقيين بسبب التسامح والانسياب
وإغماض العين عن "الظلامية الإسلامية". وبهذا نكون قد انتقلنا من الشرعية
الثورية للعمل السياسي إلى الشرعية الديمقراطية الحقيقية، في ظل النظرة
التسلطية الأحادية عينها التي ترفض اكتشاف الآخر أو حتى الاكتفاء بالنقد
المنهجي السلمي لأفكاره وممارساته مع احترام كافة حقوقه.
نظرية
الاستقصاء المغلّفة هذه ليست أقل كارثية من نظرية الحزب القائد والأوحد
المخلص للجماهير التي أوصلتنا إلى عبادة الفرد المستبد كمنهج في السياسة
والحياة. بل لعلها من وجهة نظر التحليل النفسي أفضل تعبير عن العقابيل التي
تحملها المجتمعات التي تعاني من القمع والتطويع والاستبداد. فهي تتغلف
بكلمة الديمقراطية من جهة، وتستعمل وسائل السلطات المستبدة عينها من كذب
على الآخر وقولبة له بالشكل الذي تريد لا بالشكل المتوافق مع حقيقته. إنها
الابنة غير الشرعية لغياب الثقة بالنفس والشعور الضمني بأن تمتع الآخر بحق
التعبير والتنظيم والمشاركة يعني هزيمتها المسبقة في الحياة العامة. وبما
أن كل منافس على السلطة أو القوة الاعتبارية يمكن أن يكون في لحظة ما في
وضع قوي، فإن منع الإسلاميين اليوم سيمتد غدا إلى غيرهم على مبدأ "أكلت يوم
أكل الثور الأبيض".
لقد خلصت في
دراسة ميدانية أجريتها على طلاب جامعيين إلى أن الدوغمائية موجودة بنفس
المقدار في طرفي السُلَّم أكانوا يعتبرون أنفسهم يساريين أم يمينيين.
والمشكلة هي في التربية التسلطية التي تركت بصمات عميقة في البناء النفسي
والعقلي لهؤلاء بغض النظر عن توجهاتهم السياسية المختلفة. وحيث أن من
البديهي أن يحصل تزاوج وانسجام بين الإدراك الفكري للمفاهيم والممارسة
الفعلية لها في الحياة اليومية نستنتج في الواقع تناقضا كبيرا بين
السلوكيات والخطاب النظري الذي يسبقها. فالجمود الفكري يُغلّب التقليد
والحقائق الجاهزة المعلبة على حس المحاكمة والاستنجاد بالعقل وطاقة
الابتكار.
لا تختلف
أطروحة "الديمقراطية الحقيقية" المنمقة بتعابير جميلة عن أطروحة يروج لها
صقور الإدارة الأمريكية تقول بأن "دمقرطة المجتمعات العربية تعني أسلمتها".
وقد برز عمق "ديمقراطية" هؤلاء في التصريحات الأخيرة لنائب وزير الدفاع
الأمريكي بول ولفوفتز الذي تعهّد بالتدخل لدى الحكومات الممولة للقنوات
الفضائية (كالعربية والجزيرة) لكي تفرض رقابتها على هذه الفضائيات التي
"تزّور" الحقائق في العراق. لكنه تناسى أن الصحفي يمكن أن لا ينقل كل
الحقيقة، لكنه غير قادر على الهلوسة من بنات أفكاره عن مناظر جثث الجنود
الأمريكيين مثلا. وحيث مازال القوي يفرض علينا معاييره فإلى متى ينحصر رد
الفعل لدينا في مجرد إعادة استهلاكها؟
حتى اليوم، لم
يأت أحد بدليل يكذّب منصف المرزوقي عندما يقول "الديمقراطية هي البديل
الأكمل للعنف الفج". بل على العكس من ذلك، كان ضرب الإصلاح الديمقراطي
المنتج الأكبر للعنف في المجتمعات العربية. هذه الديمقراطية البسيطة التي
لم تدنسها الديكتاتوريات والإيديولوجيات وفتاوى "الديمقراطيين الحقيقيين".
ديمقراطية احترام المرء لنفسه واحترام الخصم وتصفية أسرار الدولة ومعالجة
أمراض المعارضة.
استمرارية منهج الخراب
يحاول الإعلام
المؤيد للعدوان علي العراق أن يحصر المأساة العراقية في جانبها العراقي،
سواء كان في حديثه عن النظام السياسي أو الطاغية المستفرد أو نظام الحزب
الواحد والعشيرة الواحدة والطائفة الغالبة.. وهذا ليس بالصدفة. فمنذ دخول
القوات العراقية الأراضي الكويتية، دخل العامل الأمريكي طرفا أساسيا في
الأوضاع العراقية والمنطقة بالمعني السياسي والاقتصادي والعسكري. مما جعل
من الضروري استقراء نتائج جدلية العلاقة بين الداخل والخارج علي صعيد قضايا
أساسية يصعب تغييبها:
-القضية الأولي تحطيم البنية التحتية العراقية بشكل كامل بعد القصف الذي
قامت به قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج
الثانية 1990 والذي شمل جملة الميادين الحيوية والأساسية. فيما أصاب قرابة
700 هدف استراتيجي (57 قبل بدء العمليات العسكرية)، بما يفوق الضرورات
العسكرية باعتراف مصادر أمريكية ويزيد اعتماد العراق علي المساعدات
الخارجية. بذلك أعيدت البلاد وعلي عدة أصعدة إلي ما قبل التصنيع الرأسمالي.
في حين أن إمكانيات العراق النفطية ودعم دول الخليج غطت، دينا أو مساعدة،
فاتورة ما حطمته الحرب العراقية الإيرانية. مما حصر مشكلة المجتمع العراقي
مع الحرب الأولي بعسكرة المجتمع وهيمنة العقلية الأمنية وضحايا الحرب.
-القضية الثانية: تحطيم روح المقاومة للاستبداد الداخلي عبر السماح للجيش
العراقي بضرب كل أشكال التمرد علي السلطة المركزية إثر تداعي أجهزة الأمن
في عدة مدن عراقية. الأمر الذي غيّب إمكانية تنامي مجتمع مدني مستقل عن
السلطة السياسية المركزية في مناطق نفوذها.
-القضية الثالثة: منح الواقعين تحت الحماية الأمريكية في الشمال الحق في
سلطة مقيدة بأحزاب لا تختلف كثيرا عن الحزب الحاكم في بغداد، لا بأطروحاتها
ولا ببناء ميليشياتها ولا بمخابراتها ولا بتكوينها العشائري.
-القضية الرابعة: حرمان العراق من وسائل إعادة البناء في ظروف عادية عبر
فرض أقسي العقوبات الاقتصادية عليه في الأزمنة الحديثة. فيما عزز العقلية
الأمنية السائدة منذ عقدين من الزمن وهمّش إمكانية المجتمع علي لعب أي دور
غير الدفاع الذاتي عن البقاء، أي تعزيز كل الروابط العضوية قبل الرأسمالية.
لو استرجعنا بعضا مما حصل خلال حرب الخليج الثانية وفي ظل العقوبات
الاقتصادية التي كانت شكلا آخر للحرب ليس أقل رعبا ودمارا منها، لتملكنا
الذعر من هول المأساة التي طالت شعب العراق.
علي مدي سنوات طويلة جرت عملية اغتيال ممنهج للإنسان العراقي وانتهكت حقوقه
بشكل جسيم، وبشكل خاص منها الفئات المستضعفة من أطفال ونساء التي تتمتع في
القوانين الدولية بحماية خاصة. علي رأس هذه الحقوق الحق في الحياة الذي لا
يسمح بالمساس به حتي في ظروف الطوارئ العامة . بغطاء من مجلس الأمن اتخذت
الولايات المتحدة قرارات تجاوزت الثلاثين قرارا، من جملتها القرار 688 الذي
يكفل احترام حقوق الإنسان في العراق. لكن بقي هذا القرار تائها ولم تأبه
لتطبيقه، بل أصرت بالمقابل علي تطبيق القرار687 الذي من شأنه تكريس
العقوبات والذي أخضع رفعها أو تخفيفها لشروط سياسية وألزم العراق بدفع نسبة
عالية من قيمة نفطه لصندوق التعويضات. كما أنه منع أي شخص أو هيئة من
المطالبة بالأضرار التي أصابته بسبب العقوبات، بحيث تحول لأداة لمعاقبة
الشعب العراقي.
بعد أن كان العراق قد قطع شوطا بعيدا في محاربة الأمية وبلغت حصة التربية
والتعليم 5% من ميزانية الدولة، وهي أعلي من معدل تخصيصات الدول النامية
البالغة 3.8%، كان علي أجياله الشابة أن تعيش واقعا آخر. كانت آثار
العقوبات تدميرية كونها تراكمية ومتأتية من العزلة عن العالم والبطالة
والفقر وسوء التغذية وازدياد حالات الإعاقة والإصابة بالأمراض الانتقالية
منها والخطيرة وعدم توفر الدواء والمستلزمات العلاجية الكافية. بما يعطل
القدرات الذهنية والنفسية للأطفال الذين يشكلون نسبة 60 من المجتمع.
تبين دراسة أجريت سنة 1993 في محافظة بغداد علي عينة من 2000 طفل بين 6 و15
سنة من 50 مدرسة ابتدائية، معاناة الأطفال وزيادة مشكلات التركيز والانتباه
والاستيعاب والتذكر والفهم وعدم تحمل المسؤولية والهرب من المدرسة وازدياد
حالات سرقة النقود والمأكولات والمستلزمات المدرسية بسبب الحرمان المادي
والعاطفي والغذائي. ثلثهم كان يأتي للمدرسة دون الحصول علي طعام الفطور
ونسبة مماثلة كانت تبدأ دوام بعد الظهر دون تناول وجبة الغذاء ومعظمهم لم
يكن لديه (سندويشات) تعوض الوجبات. أما من تناول الطعام فكان فطوره مقتصرا
في أكثر من نصف العينة علي كوب شاي بدون أو مع كسرة خبز.
واليوم، كم من الوقت سيمضي قبل أن يتم الكشف علي كل معالم الدمار من
العدوان الأخير وتحصي الخسائر في الممتلكات والمساكن والمؤسسات والمقدسات
والآثار ونتعرف علي عدد الضحايا والمصابين والمعاقين والمفقودين وعلي آثاره
في الصحة النفسية للشعب العراقي وبخاصة الأطفال؟
المشكلة الأهم برأينا أن المحتل يحمل الأمراض التي يتهم بها عدوه: عقلية
الحل الأمني أولا، والقوة ثانيا، واستغلال البلاد لخدمة مصالحه ثالثا. وهو
يعتمد علي أشخاص ملطخين بملفات الفساد وممارسات عشائرية واستئصالية. إنه
بالتالي يمهد لإعادة إنتاج أنموذج ليبرالي عدمي بالمعني الاقتصادي وتسلطي
تبعي بالمعني السياسي.
اليوم وفي خضم هذا الزلزال، يتطلب طب الطوارئ المجتمعي توفير حق الحياة
ووسائل المعيشة الأساسية كالماء والكهرباء وإسعاف المستشفيات. هناك مئة ألف
طفل علي الأقل مهددين بالموت بسبب تلوث المياه، وآلاف الجرحي بدون علاج أو
دم أو مصل وعشرات آلاف المرضي دون دواء. وإن كان القانون الدولي يعتبر
المحتل مسؤولا عن هذه القضايا، فلا يمكن خلط ذلك بحق الشعب العراقي في
التصرف بثرواته وتقريره لمصيره. فيما يعيدنا للمطالبة بدور مركزي للأمم
المتحدة.
من الضروري أيضا عدم تكرار مأساة الأفغان العرب مع ما يمكن تسميته عرب
العراق من لاجئين وطلبة ومتطوعين وعابري سبيل. فهم قد عوملوا كأعداء للشعب
العراقي، بينما كان العراق الوطن الأول للكثيرين منهم، حيث ولدوا أو كبروا
فيه وذاقوا المر إلي جانب شعبه في أحلك الظروف التي عرفها.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها بشكل ملح: أولها عما سيؤول إليه مصير الشعب
العراقي؟ ماذا سيكون وضع منطقة الشرق الأوسط؟ كيف سيكون منحي المواجهات
القادمة مع البلدان المستهدفة علي اللائحة الأمريكية ومنها بداية النظام
السوري الذي أتي دور تصفية الحساب معه بضغط من الحكومة الشارونية المتلهفة
لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في ظرف موازين القوي أكثر ما تكون لصالحها؟
هل سيستجيب هذا النظام لطلبات الإدارة الأمريكية ويعمق عزلته عن شعبه مضعفا
موقفه علي الجبهة الداخلية إلي أن يتم الاستغناء عنه في أول فرصة بعد أن
يؤدي دوره كما حصل مع تؤامه الشرقي؟ أم أنه سيراهن علي الانفتاح الديمقراطي
والحوار الوطني الواسع مع كل أطراف الشعب السوري الذي همش خلال أربعين عاما
من القهر والغلبة والعصبية والفساد؟ هل سيبادر للاستجابة ولو متأخرا
لمطالبه في إحقاق الديمقراطية والعدالة والحرية ودولة القانون والتخلي عن
سياسة الحزب القائد وحالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم
الاستثنائية وتطبيق العفو العام والانفتاح السياسي والاقتصادي وتقليص دور
الأجهزة الأمنية وتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم وغير ذلك من
مطالب تتوافق مع متطلبات العصر والمصلحة الوطنية وتعيد الوطن للمواطن؟ هذه
المطالب التي عاد الشعب السوري من جديد يذكّر ويطالب بها بإلحاح خلال
السنوات الثلاث الفائتة لم يجد للأسف لها جوابا عند الحكم الجديد الذي سارع
لإضفاء المزيد من الكوابح علي الحراك الاجتماعي باصطياد الرؤوس التي أينعت
والتي اعتقد أنه حان قطافها ليعطي من خلالها درسا للآخرين.
هل ستتمكن الأنظمة العربية من تصحيح مسارها بالانفتاح علي شعوبها في ضمان
حقوق وكرامة هذه الشعوب وما يحافظ علي كيانها، وهل ستتعظ من دروس هذا
الدمار الهائل في العراق بحيث لا تضطر الشعوب المغيبة أن تدفع فاتورة
استفراد حكامها بالقرار؟
لا بد أن المستقبل القريب حافل بالمفاجآت. فإمكانيات البشر هائلة واحتمالات
أفعالها وردود أفعالها أكثر من أن تتصورها العقول، خاصة تلك التي لا تملك
بوصلة صحيحة تساعدها علي تقييم ما لا تدركه بدقة وموضوعية. تلك التي لا
تقبل بأن البشر، وخاصة أولئك الذين تفصلها عنهم مسافات، يملكون بالضرورة من
الإمكانيات ما يجعل من الغباء اختصارهم لبعض المواصفات. إن كل ممارسة
للسلطة يقابلها نوع من المقاومة. والمبرر الأساسي لاحترام الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان وفق ديباجة موقعيه أن لا يضطر المرء المظلوم للتمرد. فهل
تسمح نشوة القوة للمنتصر بإبصار كرامة الآخر قبل أن ينتزعها هذا منه بشتي
الوسائل السلمية واللاسلمية
29/04/2003
من أجل استعادة المبادرة
أزمة المثقف
العربي والفكر العربي اليوم والتي بانت بشكل صريح مع احتلال القوات
الأمريكية والبريطانية للعراق هي في جانب منها انعكاس لأزمة المجتمع
العربي. أزمة تفاقمت على خلفية واقع مرير يجر ذيول فشل معركتي التنمية
والديمقراطية. قراءتنا لهذا الواقع ستأخذ بعين الاعتبار المساحة المخصصة
لنا والتي لا تسمح بالتعمق بمجمل جوانب الموضوع، بحيث يتم التركيز على بعض
النواحي التي تساعد في تشخيص الداء والتي تكمل ما يدرج في فصول أخرى من هذا
الكتاب.
الوضع السائد
اليوم يعكس بداية عدم قدرة الأنظمة العربية على التصدي للهيمنة الخارجية
التي تبغي وضع اليد بشكل جديد على مقدرات البلدان العربية. يقابل ذلك جواب
أمني فظ على مطالب الشارع العربي. هذا الشارع الذي يتوخى مزيدا من العدل
الاجتماعي وتوزيع الثروة والانفتاح الديمقراطي والاعتراف بشرعية حقوقه
المسلوبة أو حقه في انتزاعها بالنضال. لقد تضافرت في انتهاك حقوقه هيمنة
خارجية على قراره السياسي ونهب لثرواته وحصار مرير عانى منه الأمرين. يضاف
لذلك قمع مسلط من زمر مصلحية استولت على السلطة بالقوة أو بالانقلابات
السياسية أو بالتوريث عبر الملكية أو الجملكية (كلمة حديثة أعطيت للجمهورية
التي تنحى منحى الملكية) أو ما شابه من سيناريوهات.
هذه الأقليات
السلطوية، التي أتت مبدئيا من أجل خدمة الصالح العام، لم تحترم القوانين
الاجتماعية التي ترعى مصالح الأغلبية المحكومة، بل عاثت فسادا وظلما من أجل
البقاء في السلطة أطول مدة ممكنة والاستئثار بثروات ومقدرات بلدانها. تمّ
ذلك بالقفز فوق القانون وإحلال قوانينها هي المعتمدة على تغييب الرأي الآخر
وانتهاك حقوق المواطن والقذف بمن يقاوم مشيئتها لغياهب السجون عندما لا
تلجأ للتصفية الجسدية، وإما للدفع للهجرة. والتهجير القسري لم يكن دائما
لأسباب سياسية وإنما في جانب منه اقتصادي، عندما تغلب المحسوبية الحزبية أو
الولاء للحاكم أو الاستزلام لقطب سياسي على الكفاءة العلمية والقيمة
المعرفية للمثقف. بحيث يستمر نزف العقول والطاقات الإبداعية لزمن طويل لا
تستفيد منها أوطانها ولا حتى البلدان المستقبلة في غالب الأحيان. وهي فوق
ذلك تقدم على أنها مرتهنة للأجنبي، بهدف إفقادها مصداقيتها والتقليل من
تأثيرها وتبرير ما يقترف من انتهاك لحقوقها. فالأنظمة هذه ترتعد فرائصها
خوفا ممن يتحلون بالثقافة والمعرفة والروح النقدية ولا تتوصل لاستقطابهم،
بل يسعون لكشف عوراتها حتى ولو لم يكونوا من الذين يتوخون الوصول للسلطة
بالضرورة.
هذه الأنظمة لم
يكن لها أن تكون أو أن تتأبد لولا المباركة الخارجية لها. فهي تسعى جاهدة
للاستمرار وتثبيت الاستقرار المستنقعي بأن تلعب الدور الذي يناط منها في
تكريس مصالح الدول ذات النفوذ والهيمنة. وعندما تصبح حجر عثرة أمام تحقيق
ذلك يتم إسقاطها بحجة أو بأخرى، بحيث يبقى على الشعوب أن تقاوم مزيدا من
أشكال الانتقاص لحقوقها.
أما فيما يخص
الهيمنة الخارجية التي تبدو اليوم أكثر مباشرة، فهي لم تعد تقبل بإدارة
الخيوط من بعيد وعبر أزلامها كما تفعل بعض القوى الدولية. لقد باتت أكثر
صلافة وعنجهية بوجود لوبيات تأثير وأصحاب عقائد ترى العالم من منظار
دوغمائي متطرف وتختبئ وراء أشخاص في الصف الأول للإدارة الأمريكية
(وللحكومة البريطانية الحالية) ليس لها من شخصية فذة أو اعتبارية. فما
يهمها هو تحقيق المكاسب السياسية والمصالح الاقتصادية على المدى القريب ولو
كان بالضرب بعرض الحائط بالضوابط الأخلاقية والقوانين الدولية وحقوق
الشعوب. وعيها السياسي وضعف تركيبتها الذهنية-النفسية باتت نقمة ليس فقط
على عالمنا العربي وإنما أيضا على شعوبها. هذه الشعوب التي ستستفيق من
ثباتها لتكيل باللائمة على حكامها وعلى نفسها عندما أجبرت على الخضوع
كالنعاج لأوامر لا إنسانية، كما خضعت في السابق شعوب أخرى لدكتاتوريات قيدت
على أيديها إلى حتفها.
يأتي الاحتلال
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (ولأجزاء متفاوتة من أقطار عربية أخرى)
بممارساته اليومية الاستيطانية، بما فيها من انتهاك صارخ لحقوق المواطن
وللشرعية الدولية، ليخلق عند شعوب هذه البقعة من العالم شعورا بالإحباط
والظلم وامتهان الكرامة لا يمكن إلا أن ينتج عنه رغبة بالمقاومة لرفع
الضيم. لكن المعتدي يحرمه حتى من حقه الأساسي هذا بالمقاومة، عندما يقلب
الصورة ويضع المعتدي في خانة الضحية، بإطلاقه تعبير الإرهابي على من يمارس
واحدا من حقوق الإنسان التي شكلت القاعدة الأساس للشرعة الدولية. بما يبرر
ضرب كل القوى التي تتصدى لهذه السياسة بما فيها جمعيات المجتمع المدني أو
أفراد ينبرون لمساعدة الضحايا.
هذا العنف
الممارس على شعوب المنطقة من قوى التسلط الخارجية والداخلية ليس بمعزل عن
عنف من طبيعة أخرى يمارس بحق الإنسان العربي من خلال مجتمعه وابتداء بيئته
الأسرية. فالعلاقة بين الأسري والمجتمعي والسلطوي هي حكما علاقة جدلية
وبتفاعل دائم. أحد تعبيرات هذا الظلم هو انتهاك حقوق الأقليات والفئات
المستضعفة لصالح من يملك موازين القوى. والمرأة هي قانونيا وفعليا من هذه
الفئات التي تعد مستضعفة والتي تنعم مبدئيا بحماية خاصة لوجود تمييز يطالها.
تمييز يعود للعقلية الأبوية التي ما زالت سائدة والتي تضعها في وضع دوني
وغير لائق بمرتبتها كمواطنة لها كامل حقوق المواطن الرجل.
في وضع تمييزي
كهذا حيث حق الاختلاف والتفرد لا يعترف به، هل نستغرب لماذا يعيش الفرد
وبالأخص المثقف العربي أزمة على الصعيد الشخصي وازدواجية في الممارسة تتجلى
بالخلل بين الأطروحات الفكرية والسلوكيات ؟ كيف يمكننا أن نطالبه باحترام
حقوق أخته أو زوجته أو ابنته عندما يرى الممارسات التمييزية تطال الشخص
الذي كان أول موضوع لحبه وخرج على الحياة وتعرف على العالم من خلاله؟
والخطير في الأمر هو أن يخلط الطفل بين تعبيرات الحب وأشكال الظلم
والعدوانية، حيث تختلط الأمور عليه وتنطبع شخصيته بهذا المثل الأعلى الذي
يجسد المتناقضات.
للأسف، لا زالت
المجتمعات العربية لم تعي خطورة هذا الخلل في تركيبة بنيتها الأسرية،
فتستمر بشرعنته وتطبيع الشخصية البشرية على هذا النمط من التفكير والسلوك.
في حين أن في العنف قتل للطاقات الإبداعية قبل أن تتفتح. من هنا، ما زالت
المناداة بالاعتراف بحقوق المرأة تبدو وكأنها إطلاق شعارات جوفاء بدلا من
أن تكون خطوة حاسمة في مسيرة إصلاح بنية هذه المجتمعات التي يعوزها الكثير
لتستوي أمورها.
من ناحية أخرى،
فشلت الأنظمة القومية في التعامل مع قضية الأقليات غير العربية فشلا ذريعا.
فيما جعل هذه الأقليات تمد اليد لكل عابر سبيل من القوى الخارجية. ولو كان
غير العربي يشعر بكل حقوق المواطنة والشعب في الحدود العربية لقاسم العرب
اللقمة والنقمة والسراء والضراء.
لا يمكن
للتغيير الجدي أن يفرض من الخارج وإنما ينبع من نضج الأوضاع الداخلية، بحيث
يترجم الفكر والوعي لممارسات وسلوكيات تنسجم معه. لقد رأى من غُرر
بالشعارات وتفاءل بطيب النوايا أن الاحتلال لم ولن يكن يوما لإحلال
الديمقراطية وإنما لخدمة مصالح اقتصادية وجيوستراتيجية ليس إلا. انتشار
الفوضى وغياب الأمن وخراب الوضع الاقتصادي والتراجع على كل المستويات لم
يأت بالصدفة، ولو قبلنا بدور الخوف من الآخر والجهل بتعقيدات تركيبته الذين
حالا دون معرفة كيفية التعاطي معه.
المثقف العربي
ليس من صنف واحد ولا يجوز التعميم في هذا الصدد. فهذا من الأخطاء القاتلة
لعملية الفهم التي تقضي على الحقيقة عندما تتوخى التبسيط. هناك طرفي نقيض
وما بينهما، ابتداء من الذي يقبل بالأمر الواقع ويؤدلج له لاعبا دور مثقف
السلطان وانتهاء بمن ينبري لمقاومة العسف ولو كانت الحياة هي الثمن. ومن
المشكلات البنيوية للحقبة التي نعيشها عدم كثرة المثقفين المقاومين للعسف
الداخلي والاستعباد الخارجي، بما يسهم فعليا في تغيير الواقع المعاش.
إن كانت قلة
قليلة التي دافعت عن نظام صدام حسين لأسباب مصلحية، من التجني القول أن
الذين لم يقبلوا بالاحتلال الأمريكي يقفون بالضرورة في خندق النظام العراقي
البائد. فالفصل بين الشعب والنظام يبقى من البديهيات عند من وقف ضد هيمنة
القرار الأمريكي على العراق. ومن لا يقبل بذلك فهو يشارك في الترويج
لأطروحات هدفها زرع الشقاق بين أبناء الأمة خدمة لمبدأ فرّق تسد.
هذا الشرخ الذي
حصل في الآونة الأخيرة بين طرف عراقي وآخر كويتي مع أقرانه في الأقطار
العربية الأخرى لن يطول زمنه. فصعود المقاومة المتزايد في العراق وتدهور
الوضع المرعب على أيدي الاحتلال وظهور الحقيقة حول نوايا المحتل لمن كان
مخدوعا به عوامل ستسهم في جسر الهوة هذه. من الضروري التمييز بين فئة عايشت
الواقع المر عن كثب ولم تقبل بتدنيس كرامتها من قبل النظام العراقي
المخلوع، وأخرى عاشت أزمات على الصعيد الشخصي إن في الداخل أو في الخارج
وحولتها مرارة تجربتها لضحية غير قادرة على مناقشة الأمور بموضوعية. فبانت
لديها سلوكات تدميرية موجهة للآخر وللنفس وتصلب في طريقة التعاطي مع الأمور
نتيجة تشوه صورة الذات وفقدان القدرة على التسامي والإبداع.
من ناحية أخرى،
إن كان من المؤكد أن هذه الأزمة ستترك بصماتها لبعض الوقت على واقع الفكر
العربي والقومية العربية والجامعة العربية، لا يمكننا الخلاص إلى أننا أمام
نهاية الفكر القومي، ولكن ربما نهاية التعبيرات التسلطية له. هذا الفكر هو
انعكاس لهوية تعمل على تأكيدها أطراف كثيرة في مواجهة الهجمة الشمولية التي
يتعرض لها العالم العربي اليوم بأشكال متعددة.
أليس بالإمكان
القول في نفس السياق أن وضع مؤسسة الأمم المتحدة قد اهتز بنفس المقدار
نتيجة القفز فوق المعايير الدولية التي قبعت تعمل على تبنيها الدول
والجمعيات المدنية في العالم في النصف الأخير من القرن العشرين إثر كوارث
الحربين العالمتين ؟ هل ذلك يسمح لنا بالحديث عن نهاية دور الأمم المتحدة؟
لقد نادينا منذ وقت طويل بإصلاحات في هيكلها تجاوبا مع متطلبات المرحلة،
انطلاقا من القناعة بضرورة وجود كل ما من شأنه أن يشكل ناظما للعلاقات بين
الشعوب. سواء كان ذلك مؤسسات ما بين حكومية أو غير حكومية تلعب دور قوة
موازنة أو مضادة لسلطة الدول.
تملك الشعوب
المظلومة من الطاقات الإبداعية ما بإمكانه أن يقلب رأسا على عقب المخططات
المرسومة من قبل تكتلات وحكومات متطرفة ومصلحية فاعلة على الساحة الدولية
في زمن ما. والخلل في التوازن لحساب قوى مهيمنة لا بد أن يقابله ردود فعل
تعيد هذا التوازن لصالح الفئات التي انتهكت حقوقها حتى ولو استغرق ذلك بعض
الوقت.
من هنا،
للمثقفين العرب دور فعال في إحداث التحول المنشود والخروج من واقع
الاستبداد والجهل والتحديات الخارجية إلى ممارسة المواطنة والتخلص من
التبعية وانتهاج الديمقراطية والمشاركة في معركة التطور والتنمية. فمراجعة
الذات هي خطوة أولية على طريق التغيير والإصلاح المطلوب. إنها تتيح التسامي
بالمعاناة لما فيه خير النفس والآخر، كما وتجنّب تحول العنف الكامن لعنف
مدمر. وفي الانخراط بأطر وتجمعات منبثقة عن المجتمعات المدنية استثمار
للطاقات الخلاقة في خدمة عملية البناء والتحول. فهو يتيح أيضا المران على
الحوار البنّاء بعيدا عن محاولات الاحتواء والتسلط والانتهاز. التحلي
بالحكمة والاتزان إضافة للمعرفة والخبرة في تشريح المشكلات يساعد في تحسيس
المواطن بمسؤولياته وفي بعض الأحيان تصويب مسار الحكم. فالمواطنون، ومن أي
موقع كانوا، يملكون من القدرات ما يسمح لهم بالمشاركة في القرار ويفرض
عليهم أخذ المبادرة لذلك. إن الفعل الهادف الذي تحفزه إرادة التغيير ووضوح
الرؤيا وتقديم المصلحة الوطنية وابتكار أساليب جديدة في الممارسة يحدث
تراكمات تؤسس لقفزة نوعية في بناء المستقبل. هذا الغد الذي نحضره لمن بعدنا
من المفترض أن نعمل له جنبا إلى جنب مع الثقافات الأخرى وليس بتغييبها وعلى
حسابها. فاحترام كرامة الآخر رغم الاختلاف معه هو ما يضمن تمتع المرء
بحقوقه واغتنائه من هذا الاحتكاك في عملية بناء حضارة إنسانية تقوم على
الحوار والتآخي والتعاون.
سلسلة براعم
دار
الأهالي واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنشورات أوراب
في جريمة
العدوان
فيوليت داغر
الطبعة
الأولى 2003
جميع الحقوق
محفوظة للناشر
الناشر
*منشورات
أوراب
Editions Eurabe
*الأهالي للنشر والتوزيع
سورية- دمشق ص.ب 9503
هاتف
00963113320299 فاكس 00963113335427
بريد إلكتروني
odat-h@scs-net.org
ISBN : 2-914595-23-9
EAN :
9782914595230
Violette Daguerre: On the Crime of Aggression
Buds : Studies of the
Arab Commission for Human Rights
E. mail: achr@noos.fr
فيوليت داغر
ولدت فيوليت
داغر في تنورين شمال لبنان، درست علم النفس في جامعة كان وعلم النفس
الاجتماعي والكلينيكي في جامعات باريس، حصلت على الدكتوراه من جامعة
السوربون، تدرس علم النفس منذ سنوات، شغلت عدة مناصب دولية في المنظمات غير
الحكومية لحقوق الإنسان وهي رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أصدرت عدة
دراسات في الطائفية والتثاقف وحقوق المرأة وحقوق الإنسان والديمقراطية في
سورية والدول العربية.
صدر في سلسلة براعم
هيثم مناع
الحرية في الإبداع المهجري
منصف
المرزوقي هل نحن أهل للديمقراطية
هيثم مناع
الولايات المتحدة وحقوق الإنسان
هيثم
المالح حقوق المستضعفين
فيوليت داغر
في جريمة العدوان
C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue
Gambetta - 92240 Malakoff - France
Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax:
(33-1) 4654-1913 *
Email:
achr@noos.fr
http://www.achr.nu
عودة إلى الرئيسة |